
 |
|
|||||||
« آخـــر الــمــواضــيــع »
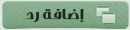 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
يتعرض هذا البحث لآثار حركة الإمام الحسين عليه السلام من الجهة الاجتماعية، والثقافية والسياسية، والمعنوية والعرفانية، ولن يكون البحث في جهة واحدة، وسنتعرف على الوضع الإسلامي، ونرى أسباب حركة الإمام الحسين عليه السلام، ثم نتتبعها من بداية انطلاقتها وصولا لكربلاء، نمر بصورة مختصرة على أحداث كربلاء، وسنركز في درس أو درسين على الجانب المعنوي لكربلاء، وخير بداية للحديث هو المنطلق القرآني لعله يكوِّن لنا صورة نفهم بها واقعة كربلاء، ونشير إلى بعض المبادئ والتصورات التي تهيئ لنا أرضية لفهم حركة الإمام الحسين عليه السلام.
الدرس الأول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين " السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين... واقعة كربلاء من أكثر الأمور تأثيرا في تكوين شخصياتنا ووعينا وثقافتنا وإيماننا ونجاتنا في الدنيا والآخرة، والمغروس في ذهن كل موالٍ لأهل البيت من بذر كربلاء أعمق وأكثر من الحديث عن جميع جوانبه، فتأثيراتها في أنفسنا من النواحي الروحية والثقافية والاجتماعية متعدد ومتشعب في وجودنا وتكويننا. ونحاول التعرف على هذه الحقيقة التي زرعتها يد القدرة الإلهية في نفس كل مؤمن، والغاية هي الالتفات إلى ركائز الحركة الحسينية وآثارها، ومحاولة تفسيرها، وهذا ليس بالأمر الهين، بل سوف يتبين استحالته. تكرر ذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم كثيرًا، وفي قصص متعددة، وغالبيتها تدور حول دوره في توطيد عرى التوحيد، ومنها عن دعوته لقومه ومواجهته لعبادة الأصنام، وما حدث بعدها من محاولة إحراقه، ووصيته لأبنائه بالتوحيد، وبناء الكعبة، ومعظم الآيات التي تذكره -إن لم يكن كلها- تدور حول المعركة التوحيدية التي خاضها في ترسيخ كلمة (لا إله إلا الله)، لهذا صار عليه السلام أب التوحيد، وكل موحد بعده تحرك على إثر حركته عليه السلام، وحديثنا يتناول قصة تختلف عن سائر القصص، فليس لها شأن في الناس أو المجتمع أو الدعوة لله تعالى، فهي لا تدور بين إبراهيم وبين أحد من الناس. قال تعالى في محكم كتابه: {وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (99) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (100) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107}(سورة الصافات ) إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ حركة إبراهيم عليه السلام هي حركة نحو عبادة الله، أو كما يصطلح عليه أهل العلوم البحثية سير وسلوك إلى الله، فلم يتحرك هنا ليدعو أحدًا، ولو كانت هناك دعوة لأحد فهي في طي هذا السير السلوكي، يعيننا على ذلك ويؤيده: { وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقِيّاً } (سورة مريم ) وفي حديث عن الإمام علي عليه السلام يبين عمق هذه الحركة الإبراهيمية، كما روى ذلك الشيخ الصدوق(ره) في تفسير {إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ} فذهابه إلى الله وتوجهه إليه عبادة واجتهاد وقرب، {رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ} وطلب منه أن يهب له من الصالحين {فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} عبادة الله تتنوع فمنها الخلوة مع الله والتهجد والتحميد والتمجيد بأنواع الذكر وفنون المناجاة والصلاة والصيام والحج الذي هو من سنة إبراهيم عليه السلام لكن ليس هناك عبادة اسمها ذبح الابن، ولكن في حركة إبراهيم لله وعبادته تأتي الآيات القرآنية فتقول إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ هذا الذبح لم يكن لغاية الدفاع عن الدين أو الدعوة لله، هذه الحركة وهذا الإقدام بأن يذبح إبراهيم ابنه نوع من العبادة لله نحن لا نليق بها ولا نفهمها. نلاحظ هنا أن إبراهيم عليه السلام بلغته الكشفية الربانية في المنام وليس عن طريق ملك من الملائكة، وكأن الإسرار بهذه القصة منتهى الغاية من الخلة بين الله وبين إبراهيم الخليل. (أصل التخلل) دخول الشيء في الشيء، ثم استعمل في الصديق الذي لا تكتم عنه سراً فهو متخلل فيك، يعرف كل ما لديك وكل ما تخفيه عن كل أحد، الأصدقاء كثيرون ولكن الخليل منهم الذي تطلعه على كل ما لديك، ورؤيا الأنبياء تختلف عن رؤى الناس العاديين، فهي كاشفة عن اليقين { إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} تكشف لإبراهيم عليه السلام بأن هناك أمرًا متحققًا في الخارج وهو أن يذبح ابنه، عزم إبراهيم (ع) على ما ورده من أمر الله، ولكنه أراد أن يهيئ إسماعيل عليه السلام فهو الغلام الحليم، لأن البشارة التي جاءت إبراهيم { فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ } لم تذكر ابنًا قويًا بل غلامًا حليمًا، يقول السيد الطباطبائي: ( لم يوصف نبي بأنه حليم إلا إسماعيل وأبيه إبراهيم عليهما السلام، قال تعالى: { إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ} وهذه الخاصية كانت محلًا للإشارة أو البشارة، إسماعيل في ذلك الوقت لم يكن رجلا { فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ} وإنما غلام يسعى، ويقال ربما أنه إشارة لسن المراهقة الذي يصبح فيه الابن ساعيا فكان الرد من إسماعيل { يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ} أنت مأمور بأمر فافعله، لم يقل يا أبتِ الوظيفة التي هي ذبحي اذبحني، وهذا يشير إلى التضحية والإقدام، وإذا كان له أثر علي {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ } ورد في الروايات أن إبراهيم عليهما السلام لما هَمَّ بقتل إسماعيل، لم يخبره ولم يخبر أمه وإنما أخرجه معه إلى وادٍ في مكة وأخبره بالرؤيا، قال له إسماعيل عليه السلام : (يَا أَبَتِ اشْدُدْ رِبَاطِي حَتَّى لَا أضْطَرِبُ، وَاكْفُفْ عَنِّي ثِيَابَكَ حَتَّى لَا يَنْتَضِحَ عَلَيْهَا مَنْ دَمِيَ شَيْءٌ فَيَنْقُصُ أَجْرِي وَتَرَاهُ أُمِّي فَتَحْزَنُ، وَاشْحَذْ شَفْرَتَكَ، وَأَسْرِعْ مَرَّ السِّكِّينِ عَلَى حَلْقِي لِيَكُونَ أَهْوَنَ عَلَيَّ فَإِنَّ الْمَوْتَ شَدِيدٌ) { يا أبتِ افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين...} أسلم أي عزم على الأمر عزيمة أقفل معها أبواب التراجع، أي ليس هناك تراجع، بل أقدم إبراهيم عليه السلام فعلا وعملاً على ذبح ابنه، نشير إلى أن غريزة حب الابن من أعمق الغرائز الموجودة لدى الكائنات، وبالخصوص كلما ازدادت إنسانية الإنسان ازداد حبا للآخرين فكيف بحبه لابنه، وكلما ازداد هذا الابن رقة وكرامة وجلالا كلما ازداد التعلق به. لكن نشير إلى أن هناك من يذبح الناس وحتى ابنه قسوة وغلظة، وفي رواية للمؤرخين عن أحد الصحابة أنه قال: أمران أحدهما يضحكني والآخر يبكني، يضحكني أننا كنا نصنع الإله الذي كنا نعبده من التمر فإذا اشتد بنا الجوع أكلناه، وأما ما يبكيني فهو أني حينما كنت أدفن ابنتي وكنت أحفر لها القبر يقع الغبار على لحيتي فكانت تنفض الغبار عن لحيتي، وهذا منتهى القسوة التي يمتلكها بعض الناس، أما أولياء الله فهم في منتهى الرأفة والرحمة فكيف أقدم نبي الله إبراهيم عليه السلام على هذا العمل، حتى نفهم هذا لنتأمل كيف يوصينا القرآن باتباع إبراهيم عليه السلام { وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَٰهِيمَ خَلِيلً } الآية فيها إشارات بأن علة ومصدر الخلة التي تحققت في إبراهيم عليه السلام مع الله تعالى هي إسلام الوجه إلى الله، وهذه هي الخاصية الأولى. الخاصية الأخرى هي الوظيفة التي كلف بها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وهي عبادة خاصة بين إبراهيم وربه تعالى، وهي ليست تكليفاً كلف به البشر، ولا بعضهم، ولا حتى الأولياء منهم، بل لم يرد هذا التكليف إلا لإبراهيم عليه السلام، لا يوجد في الشرائع تشريع اسمه أن تذبح ابنك، هذا الأمر ليس له مصداق مكلف به إلا إبراهيم عليه السلام { فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا } التكليف الذي أوكل إليك الوظيفة التي صدقتها يعني جريت عليها كما أمرت فأصبحت صادقة وتحققت { إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِين* إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاَءُ الْمُبِينُ* وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ* وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخرينَ* سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ* كَذَلِكَ نَجْزي الْمُحْسِنِينَ* إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِين* وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مِّنَ الصَّالِحِينَ } فإن المبشر به الأول ليس إسحاق لأن الآيات القرآنية بعد أن ذكرت ما جرى بينه وبين ابنه الحليم ذكرت أنه بشرناه بإسحاق، وهذا ما يشير إليه السيد الطبطبائي: أن هذا دليل على أن المبشر به في الأول هو إسماعيل، {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} الوظيفة التي أوكلت إلى إبراهيم عليه السلام انتهت حينما رفع سكينه وقد شحذها ووجه ابنه للأرض، وتله للجبين أي جهزه وأعده للقتل إلى هنا انتهت وظيفة إبراهيم عليه السلام، هذا النحو من التسليم والعبودية والخضوع لله عز وجل لم يبلغه كائن ولم يكلف به إنسان ولم يصل إليه أحد قبل إبراهيم عليه السلام، كلنا مكلفون بنحو من الاتجاه لله عز وجل والتقرب إليه، لكن لو كلفنا بأكثر مما هو جميل ومناسب لنا لم نستطع أن نستوعب تلك الحالة أو المقدار من العبودية لله عز وجل. إبراهيم عليه السلام بلغ أن يكون في توجيهه لابنه ورفعه السكين لذبحه نوع من الخضوع والعبودية لله تعالى تتناسب مع كمال إبراهيم عليه السلام، إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وقف كمالهما عند هذا الحد والوظيفة، أما الذبح فلم يتحقق لإبراهيم ذبح إسماعيل، ولا إسماعيل ذبحه إبراهيم، هناك من حقق هذه الوظيفة فكان كماله في أن تتحقق وظيفة الذبح. أما حد وظيفة أبي عبد الله الحسين عليه السلام فهي أن يقتل ابنه حقيقة، انظروا إلى ظروف كربلاء ستجدون أضعافا مضاعفة مما أحاط بقصة إبراهيم عليه السلام أي حالة من العبودية كانت بين الإمام الحسين عليه السلام وبين الله جل وعلا. سنتعرض في دروس قادمة إن شاء الله إلى ظروف كربلاء، فلها تفسير في واقعها الاجتماعي الذي دارت فيه، ولها تفسير ومعنى في قضيتها التاريخية والإنسانية التي تعم الإنسانية من أولها إلى آخرها، فهي أعلى من درجة الظروف الاجتماعية الآنية، لكن كلا الأمرين لا يفسران قضية كربلاء. وإذا أردت أن تبحث عن قضية كربلاء فابحث عن قضية كربلاء بين الحسين عليه السلام وبين ربه، لا يظن أحد أن الأسباب الطبيعية فرضت على الإمام الحسين عليه السلام أن يضحي، لا يظن أحد أن هناك في هذا الوجود من يضحي لأجله الإمام الحسين عليه السلام، منطلق ما جرى عليه سر بينه وبين الله، وسائر الأشياء هي تدع ذلك السر لله. شاء الله أن يرى الإمام الحسين عليه السلام قتيلا وليست الظروف الاجتماعية هي التي تفسر لنا وإن كانت تستحق منّا البحث والنظر، وفي مستوانا يمكن أن نبحث فيها ونتحدث عنها ونشير إليها. ولكن حقيقة واقعة كربلاء أين نجدها أين نبحث عنها؟ إن شاء الله بتتبع قصة إبراهيم عليه السلام عرفنا أن هناك قضية أخرى تختلف، إبراهيم عليه السلام في هذه القصة ما كان يذبح ابنه إسماعيل لأجل أحد أو يدافع عن أحد أو يضحي بأحد كانت هناك علقة ربانية من الله كمالها في الاستجابة لهذا الأمر. ( شاء الله أن يراني قتيلا ) لعلنا نبحث في هذا المعنى ونتفطن فيه ونشير إليه فلا يمكن أن نفهم حركة الإمام الحسين عليه السلام قبل أن نشير ولو إشارة من بعيد إننا كما نرى في كل حركة تحركها الإمام الحسين عليه السلام أداء لوظيفة اجتماعية في نجاة الأمة وإصلاحها (خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي)، علينا أن نفهم أن لكل خطوة في كربلاء معنى رباني للعلاقة بين الحسين عليه السلام وربه، وما ندركه من هذه العلاقة لا يمكن أن يقدر بنقطة في بحر الحقيقة، بل إن أهل العرفان لما عجزوا عن إدراك تلك الحقيقة وتفسيرها تصوروا معنى فقالوا على لسان الإمام الحسين عليه السلام: هجرت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطـــعتني بالحــــب إربــــــــــاً لما مال الفؤاد إلى سواك هذه الأبيات تعبر عن أسمى وأعلى ما يمكن أن يبلغه الإنسان العادي في فهم حركة الإمام الحسين عليه السلام، فهي من أجمل وأجل الأبيات، لكن لا بد أن ننظر إليها بمقدار وعي البشر وإمكان ما يصل إليه من فهم هذه العلاقة بين الإمام الحسين عليه السلام وبين ربه، فهذه الأبيات التي نظمها أهل المعرفة حينما لم يدركوا تفسيرا لما جرى، أو أنهم أدركوا أن هناك أسرارا لا يمكن أن ترى، فمقدار ما بلغ إدراكهم أن ينظموا هذه الأبيات ليصوروا بها حركة الإمام الحسين عليه السلام. المروي أن عليا الأكبر لما خاض حملته الأولى والتي ذكّر فيها بحملات جده حيدرة الكرار عليهما السلام وقد قتل الأبطال والفرسان وذوي الحمية، عاد وقال: يا أبي قتلني العطش فضمه عليه السلام إليه ووضع لسانه في فمه فإذا هو كالخشبة اليابسة، بعد مقتل علي الأكبر كيف أصبح لسان الإمام الحسين عليه السلام. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره السلام عليك يا أبا عبد الله لعن الله ظالميك ولعن الله قاتليك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به التعديل الأخير تم بواسطة بثينه عبد الحميد ; 09-21-2021 الساعة 08:43 AM |
|
#2
|
|||
|
|||
|
الدرس الثاني
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره السلام عليك يا أبا عبد الله. الدرس الماضي كان لتهيئة الجانب التفكري للبحث حول أحد أبعاد واقعة كربلاء، وربما تحفيز للعقل والقلب للنظر في هذا البعد، وإلاّ فإننا بلا شك لم نعط المسألة حقها، فقط أشرنا إلى أن إبراهيم عليه السلام في ذبحه لابنه كانت هناك حالة ربانية عبادية بينه وبين الله عز وجل، وهذه القصة القرآنية لإبراهيم عليه السلامخلاف سائر القصص الإبراهيمية لا تعود إلى دور إبراهيم الاجتماعي والدعوة إلى الله عز وجل، بل قصة اختصت بين إبراهيم وربه، وربما كانت هي سبب للخلة، ذكرنا الآية القرآنية التي نستفيد منها أن منشأ خلة إبراهيم عليه السلام وبلوغه هذا المقام هو تسليمه لله عز وجل في إقدامه على ذبح ابنه، وهذه الواقعة بلغ بهاإبراهيم مقام الكمال الإبراهيمي، لكنها لم تتم على نحو كمالها المطلق إلاّ على يد الإمام الحسين عليه السلام، إبراهيم عليه السلام علم وأقدم، ولكن الإمام الحسين عليه السلام قام بقتل أبناءه بل بتقديم نفسه بين يدي الله عز وجل. النقطة التي أريد الإشارة لها أن هذا البعد الرباني هو الأساس والمنطلق، والأبعاد الثانية تجليات، بمعنى أن ما جرى على رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين وبالخصوص الإمام الحسين عليه السلام لو أردنا استعمال لهجة زماننا لقلنا إنه أمر متفق عليه سابقاً، وبه استكمل الإمام الحسين عليه السلام كماله،نعم الأبعاد الأخرى الإصلاحية والاجتماعية وإحياء الدين أبعاد حقيقية أيضاً لحركة الإمام الحسين عليه السلام ولكنها تنُطوي تحت ذلك البعد، وهذه مسألة في غاية الدقة إن شاء الله لنا عودة إليها في الدرس الأخير، وسنرى أن قصص إبراهيم عليه السلام تعيننا في فهم الدور الحسيني. في هذا الدرس نشير إلى بعد آخر من أبعاد واقعة كربلاء، ويجب أن نتحرك لفهمه، فنحن جميعاً في حاجةلإدراكه، فهو يؤسس لمبادئ فكر إسلامي صلب متماسك. لا بأس من الإشارة إلى مقدمة تاريخية للحديث حول الخريطة التاريخية الزمانية وكيفية تسلسل حركة الفكر الإسلامي من بداية الدعوة الإسلامية إلى زمان حركة الحسين عليه السلام على نحو الاقتضاب الشديد. رسول الله صلى الله عليه وآله زرع بذرة الإسلام والفكر الإسلامي، وسعى لإحياء أمة مفكرة واعية ومدركة، والقرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله كلها تصب في هذا الموضوع. الشهيد الصدر يقول بما معناه: إذا استثنينا القرآن الكريم نجد أن الرسول صلى الله عليه وآله جاء بمعاجز كثيرة نقلها المؤرخون من حديث الحصاة بين يديه إلى حركة الشجرة إلى آخر معاجزه، لكن قضية بناءً فكري متكامل يحيط بالإنسان من جميع جوانبه ويكون كالشجرة الثابتة التي تمتد وتنطلق من منبع واحد في غاية الأهمية والاعجاز، الثقافة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله لا تشكل حركة جامدة في تسلسل الفكر الإنساني فقد جاء بمجموعة من المعارف لا تسمح بانضمام معارف أخرى لها، رسول الله صلى الله عليه وآله طرح الأسس والمنطلقات ثم دعا الأمة وحركها نحو تعبئة تلك الأسس والاستمرار فيها، ولو أن مشيئة الله اقتضت أن ترى عليا عليه السلام على رأس العالم الإسلامي لكان الإنسان غير الإنسان والواقع غير الواقع، ولا نقصد وصول الإنسان إلى الكمال المادي فقط، وإنما ربما بلغ الإنسان مراحل التكامل الحقيقي. على كل حال توفي الرسول صلى الله عليه وآله فما هي المرحلة الأولى؟ تلك البذرة والنُظم الثقافية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله ماذا جرى عليها ؟ في عهد الخليفة الأول والثاني نلاحظ ثلاثة نقاط: 1- إنهما تمسكا بظاهر الإسلام و النسك والزهد والعدل الظاهري في التقسيم وأداء الصلوات، وهذا من جهة حافظ على شيء من ظاهر الإسلام، لكن من جهة أخرى كان هو أدهى وأمر ما أصاب الإسلام، لأنهما بهذا الطرح إذا ضممنا إليه ما يليه من النقاط لوجدنا إنهما شعبا في الإسلام طريق الفكر الإسلامي فصار يتحرك إلى جهة أخرى. وهذا من الأمور المعروفة والمسلمة تاريخياً. 2_ إنهما زويا الأمر عن أهل البيت عليهم السلام، وعملا على إبعادهم بكل وسيلة وطريقة. علي عليه السلام الشخصية الثانية في حياة الرسول صلى الله عليه وآله ما من معركة إلا ولواؤها عنده وما من إقدام إلا وعلي إلى جانبه ما من مدح إلا وعلي على رأسه وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله أبعد علي عليه السلام تماما عن الساحة الإسلامية، لاحظوا الأمة الإسلامية في زمان الرسول صلى الله عليه وآلهكان عدد الداخلين في الإسلام يشكل عددا قليلا جدا، معظم المسلمين تعرفوا على الإسلام في السنة الثامنة والتاسعة والعاشرة في أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وآله ثم جاء الفتح الإسلامي وانتشر الإسلام ولم يكن لعلي ذكر أو دور أبدا. 3_ لم يكونا – الخليفة الأول والثاني - من أهل النظر والفكر، وهذا باعترافهما حينما يسئل الأول عن الآيات القرآنية يصرح ( لو أن هذه انطبقت على هذه أهون علي من أن أقول في كتاب الله مالا أعرف)، وكذلك سنة الرسول ولم يكن لهما توجه ثقافي أو طرح علمي والشواهد كثيرة على أن فهمهم للإسلام كان سطحيًا وفي أقل الدرجات. الخليفة الثاني كان يخطئ في قضايا كثيرة من قضية إرث الجدة إلى مهر المرأة إلى قضية متعة الزواج وغيرها، مضت الخلافتين بهذه المواصفات، وجاءت الثالثة التي هي انسجاماً لحركة الأولى والثانية، بمعنى أن ما مر به الإسلام في زمان الأول يشير تماما إلى المرحلة القادمة وهي مرحلة الخليفة الثاني، والثانية تشير إلى الثالثة، كانت هناك حركة انسجام وانسياب من أبي بكر إلى عمر ومن ثم عثمان، ولا أحد ينكر أن أبا بكر عين عمر بنفسه، ولا ينكر أحد أن عمر عين عثمان، لأن التشكيله التي عينها كانت تؤدي إلى عثمان حتما، حتى قبل وفاته ذهب ابن عباس إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال لا تدخل مع هؤلاء الجماعة؛ لأن هؤلاء نتيجة اختيارهم واضحة فعمر اختارهم بطريقة تؤدي إلى عثمان، الغرض من هذا الكلام هو أن الحركة كانت منسجمة بصورة تلتئم مع بعضها البعض، في عهد عثمان استكمل الانحدار الفكري في العالم الإسلامي وظهرت أمور كثيرة وتصرفات تتعارض مع مبادئ الإسلام وقيمه، أخذ عثمان أولا يتصرف في بيت مال المسلمين ويعطي أبناء عمه وأعمامه بير وجه حق، وعلى سبيل المثال الحكم بن أبي العاص الذي كان طريد الرسول صلى الله عليه وآله، فقد كان إذا مر الرسول صلى الله عليه وآله صار يقلد مشيته ويسخر منه، وكان يتسلق حيطان بيوت النبي صلى الله عليه وآله وكل هذا بعد دخوله في الإسلام بعد فتح مكة، ونفاه الرسول صلى الله عليه وآله وقال له: ( لا تساكنِّي في المدينة) وبقي منفيا في عهد الأول والثاني ولما جاء عثمان أرجعه بل وسلطه على كثير من إدارة شؤون المدينة ووهبه من الأموال الكثير، ثم جاء ابن عمه مروان بن الحكم الذي اصبح المدير الحقيقي في عهد عثمان وزوجه ابنته وأعطاه خُمس صدقات إفريقيا التي كانت تعد بألفي ألف، وأعطى الحارث ابن الحكم وعبد الله بن خالد ابن أسيد وسعيد بن العاص من بني أمية، وعين الوليد بن عقبة أخوه من أمه والياً مع أنه كان معروف بفسقه وشربه للخمر حتى أنه ذات يوم كان كعادته يشرب الخمر في الليل مع غلمانه ومغنيه ثم جاءت صلاة الفجر وصلاها جماعة أربع ركعات، وقال لو أردتم أن أزيدكم فدخلوا عليه وأخذوا خاتمه، وشاع الخبر إلى آخر القضية حتى أقيم عليه الحد بإقدام من أمير المؤمنين عليه السلام، نعم اضطربت الأمور في عهد عثمان وانتهت إلى خروج الناس عليه. في المرحلة الرابعة جاء علي عليه السلام، لكن ورود علي عليه السلام كان أمراً على عكس التيار، الحركة التي جاءت من الخليفة الأول ثم الثاني ثم الثالث كانت تشير بشكل تلقائي إلى خلافة بني أمية، جاء علياعليه السلام كموقف شاذ وحركة غير منسجمة، عانى ما عانى سلام الله عليه ولكن في فترة خلافته طرحت بعض المسائل والجوانب الثقافية، فقد كان هناك التفات إلى معاني التوحيد واستمع إلى خطبه الكثير،والتفت إليها كثير من الأشخاص، فبُذرت بذرة روحية وثقافية، ولو أن المشيئة الإلهية اقتضت والظروف سمحت ودام حكم علي عليه السلام كما حكم عمر أو عثمان لكان الأمر غير الأمر لأن علي عليه السلام في تلك الفترة الزمانية القصيرة أعاد للفكر الإسلامي حركته. المرحلة الخامسة: مرحلة معاوية، بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام اتجهت الأمة إلى معاوية وخلافته،وإذا طالعنا التاريخ وجدنا أنه أدهى وأمكر وأسوء وأشد على الإسلام من كل السابقين، لولا أنه كان لهم السبق في الأمر لكان له السبق، فما تبقى للإسلام من قيم ومبادئ ومعرفة قضى عليها معاوية، سلط فسقته وفجاره سفاكا على رقاب المسلمين، سلط زياد بن أبيه الذي اعتمد أسلوب القسوة والإخافة والإرهاب، وسلط سمرة بن جندب وبسر بن أرطأة على رقاب الناس، وبالخصوص قضى على كل من كان بينه وبين علي علاقة أو تأيد أو محبة، وأراد معاوية أن يمحو الإسلام بمحوه لعلي عليه السلام حينما يسب عليا في صلاة كل جمعة، فالسب لا يطيح بعلي وإنما بالإسلام نفسه، واجه معاوية الإسلام صراحة، فعندما أراد أن يستلحق زياد بن أبيه الذي كان ينسب لعبيد، كان هذا الموقف مواجهة علنية لشريعة الرسول، فرق بين إنسان يذنب ذنبًا وبين من يقول أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله ليس هو الحق، الرسول قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)، وهذا قانون إسلامي يعمل به، وخالفه معاوية مخالفة صريحة للإسلام، وآخر خطوات معاوية أنه استخلف أبنه يزيد وأجبر المسلمين على المبايعة. الآن إذا نظرنا إلى هذه الحركة وأردنا أن نرسم التحرك في المجتمع الإسلامي وكيفية استقبال المجتمع الإسلامي له، لأمكننا القول أنه في سنة 60 للهجرة أي بعد الهجرة بـ 60 سنة وبعد وفاته (ص) بـ 50 سنة كان الإسلام يلفظ أنفاسه الأخيرة ولم يبق لدى للمسلمين شيء، وهذا ليس بغريب فالكثير من الأديان جاءت وبعد فتره زمنية تم الإلقاء بمادتها وأصولها وجذورها في مراصد التاريخ وكتبه، الإسلام كاد أن يلحق بها، لولا الحسين عليه السلام لكان الإسلام من الأديان التي مضت وانتهت ولذكر فقط في كتب التاريخ أنه كان هناك قرآن ومبادئ. الجانب الذي أريد أن أشير إليه كيف تقبلت الأمة الإسلامية ذلك ؟؟ وما هو الداء الفكري الذي عانت منه فاستسلمت لهذا التيار؟ ثقافتنا ومعارفنا يجب أن تبتني على أسس فكرية قوية وثابتة وراسخة، ونستطيع أن نطور ثقافتنا ومعرفتنا ونضيف لها دون المس بقواعد وأصول ثقافتنا وفكرنا الأصيل. اليوم نحن في أمس الحاجة لإدراك هذه الحقيقة والالتفات لها، في الأزمان السابقة كانت لديهم معلومات ومعارف كثيرة، كانوا يعرفون أن العادل يتولى الحكم، ويعرفون فضل أهل البيت عليهم السلام، ولم يخفهذا الأمر على أحد، حتى الذين كانوا يقفون في وجه الحسين عليه السلام لا ينكرون أنه الأفضل، لكن ميزانهم الثقافي هو الذي أصيب بالداء والبلاء، كانوا لا يرجعون فكرهم وثقافتهم إلى قواعد واضحة فتختلط عليهم الأمور، وكمثال من الأمثلة أنه بعض الذين كانوا قادة في قتل الإمام الحسين عليه السلام كانوا قبلهاقادة في جيش الإمام علي عليه السلام، مثل شبث أبن ربعي الذي قاتل معاوية، ثم لما خرج الخوارج أصيب بالاضطراب الفكري فانتقل لهم، ثم سمع حجج علي عليه السلام فعاد لصف الإمام عليه السلام، ثم شارك في قتل الإمام الحسين عليه السلام، ثم خرج في جيش المختار، وهذا منتهى التقلب والضياع الفكري، نحن الآن في زماننا يجب أن نرتب ثقافتنا لتكون ثقافة راسخة ذات أصول قوية نستطيع أن نتعامل مع كل الأطروحات في الجانب العلمي والمعرفي والترتيبي والفكري، مسميات كثيرة نحتاج لها، وأول ما يجب أن ندركه ونعرفه كيف نستفيد من هذا العلوم والمعارف في تطوير فكرنا ومجتمعنا الديني، كيف يؤدي هذا الأمر إلى تماسك عقيدتنا، لكن مع الأسف الشديد ظهرت كثير من الظواهر في أنحاء العالم الإسلامي، أصبحالإنسان المسلم مرة يقتنع بهذا الجزء من المعرفة ويقدمه ويؤيده ومرة أخرى يميل ويرجح ذلك النوع الآخر من المعرفة، مرة يطرد نوع من المعرفة بدون سبب ومرة يقتنع ويقبل بنوع آخر بدون ميزان، الذين وقفوا في وجه الحسين عليه السلام ما كان يخفى عليهم مقام الحسين عليه السلام والمروي أن أنس بن سنان الذي شارك في قتل الإمام الحسين عليه السلام مع شمر اللعين، ذهب إلى الأمير وقال: إملأ ركابي فضة أو ذهبا أنا قتلت الملك المحجبا قتلت خير الناس أما وأبا كان يدرك هذه الحقيقة ويعرف مقام الإمام الحسين، ومع ذلك نفسه الديئة وسوء حظه وشقاؤه الأبدي قادته ليقف ذلك الموقف الذي تهتز له السماوات والأرض، لعن الله ظالمي آل محمد من الأولين والآخرين. |
|
#3
|
|||
|
|||
|
الدرس الثالث
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، السلام عليك يا أبا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك لعن أمة قتلتكم ولعن الله أمة ظلمتكم. نستمع في شهر محرم عادة إلى أحداث يوم العاشر من المحرم، وربما نجهل الكثير من حركة الحسين عليه السلام؛ نظراً لتركيزنا على مجريات أحداث يوم العاشر حتى يكون لدينا تصورا عن ساحة المعركة وأشخاصها والأدوار والمهام التي قام بها أفراد المعسكرين، والغايات والأهداف التي كانوا يرجونها، ولكن علينا الاطلاع على تاريخ وطباع وخصائص الأمة الإسلامية والشخصيات الموجودة في تلك الفترة، فلا نستطيع إدراك دور شخص ذُكر في يوم العاشر بمجرد معرفة ما قام به في ذلك اليوم، فمن المناسب التعرف على وضع الأمة الإسلامية وحركة الحسين عليه السلام. لما استولى معاوية على الحكم سنة أربعين من الهجرة ودامت له السلطة لمدة عشرين سنة، وتعد أطول فترة حكم بالنسبة لحكّام بني أمية، فالشام منذ فتحها ودخولها في سلطة الدولة الإسلامية محكومة من بني أمية، فقد حكمها يزيد بن أبي سفيان أولًا ثم أخوه معاوية بعده مباشرة،، هذا بخصوص الشام أما سائر البلدان الإسلامية كانت آخر ثلاثين سنة منها-قبل عاشوراء- محكومة أمويًا تقريبًا؛ لأن فترة خلافة أمير المؤمنين عليه السلام لمدة خمس سنوات كانت فترة اضطراب وحروب، وقبل أمير المؤمنين عليه السلام كان عثمان الأموي في حدود عشر سنوات هو الحاكم الفعلي على العالم الإسلامي، وبعد وفاة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام عاد حكم معاوية لمدة عشرين سنة. وإن معاوية قد هيأ الأمر لمبايعة ابنه يزيد قبل سنوات من وفاته، فلما هلك معاوية في سنة 60 للهجرة في شهر رجب كانت المسألة الأساسية التي واجهت يزيد هي ثتبيت حكمه ومواجهة من يتخوف منه عدم القبول ببيعته والخروج على حكمه، فكتب إلى عامله في المدينة: أنه عليك بأخذ البيعة بالخصوص من الحسين عليه السلام وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن الخطاب، ولم يكن هذا الأخير يشكل خطرًا. أما عبد الله بن الزبير فلم يبايع وذهب إلى مكة كما فعل الإمام الحسين عليه السلام، وكان ذلك في نفس الفترة وكلاهما وقف في وجه الحكومة اليزيدية، ولكن كانت نتائج حركتهما مختلفة تبعا لاختلاف شخصيتيهما. عبدالله بن الزبير تمكن من تكّوين حكومة ودولة، وامتدت سلطة حكومته مكة والمدينة والكوفة والبصرة حتى بلغت دمشق -فقد عين له حاكماً في دمشق-، وكاد أن يستتب له الأمر لولا بعض نقاط الضعف في خصائص شخصيته. أما الإمام الحسين عليه السلام فحركته ذات مدى قصير، ولمدة أشهر قليلة، ربما يصعب الآن أن نشير إلى نقاط التمايز بين هاتين الشخصيتين، ولكن نشير إلى نقطة واحدة فقط وهي إن عبدالله بن الزبير كان دوره مع وجود الحسين عليه السلام دورًا غير قابل للتطبيق والخروج؛ لأن قلوب الناس وتوجهاتهم وتطلعاتهم كانت مع الإمام الحسين عليه السلام لذلك لم يكن لابن الزبير أي صلاحية ليقوم بالدعوة لنفسه مع وجود الإمام الحسين عليه السلام. وقد اختلف أسلوب حركتيهما اختلافا جذريا واتجه كل منهما اتجاها مختلفا، لكن بحثنا في مسألة فكريه ثقافية وليس من جهة تاريخية أو لتوضيح الغايات التي كان يريد أن يحققها الإمام الحسين عليه السلام أو الزبير، الحسين عليه السلام استدعاه حاكم المدينة من طرف يزيد وأمره بالمبايعة فلم يقبل ولم يبايع وخرج إلى مكة وبقي فيها شهر شعبان ورمضان وشوال إلى بداية ذي الحجة، وفي بداية هذه الفترة كانت تأتيه رسائل من معظم رؤساء القبائل الكوفية ليخرج إليهم، إلا أن نظرة أهل الخبرة والمعرفة والموازين العقلانية المعروفة المعهودة بين الناس كانت كلها تدل على أن خروج الإمام الحسين عليه السلام لن يؤدي إلى الإطاحة بالدولة الأموية. والملاحظ أن الذين نصحوا الإمام الحسين عليه السلام كلهم تحدثوا بنفس اللهجة، وإن نتيجة خروجه اعليه السلام وما يتأمله من أهل الكوفة أمر لن يتحقق، فأسباب النصر والغلبة والإطاحة بالدولة الأموية غير متوفرة، ونشير لبعض الأمثلة: الأول: عبدالله بن جعفر، فقد نصحه بعدم الخروج وسعى في أن يستحصل له على أمان من والي المدينة الذي كان أكثر عقلانية من يزيد، حيث أنه أراد أن يعطي الإمام عليه السلام الأمان للبقاء في المدينة لكن الإمام عليه السلام لم يقبل منهما. الثاني: محمد بن الحنفية، أصر على الإمام بعدم الخروج للعراق، وأشار عليه بالتوجه إلى اليمن إذا كان مُصرًا على الخروج حتى يستتب له الأمر. الثالث: عبدالله بن العباس، والوارد أنه ألح على الإمام الحسين عليه السلام مرة بعد أخرى، ووصل به الأمر أن يستعمل كل ما يملكه من وسائل تثبيط وإعاقة للحسين عليه السلام عن الخروج، فذهب إليه وقال له: يا أبا عبد الله أأنت عازم على الخروج إلى العراق، فقال الحسين عليه السلام: نعم، فقال له ابن عباس: والله لولا أن أخاف أن يجتمع الناس حولنا لأخذت برأسك ومنعتك من الخروج. كان الأمر جليا وواضحا عند عامة الناس، بل يكاد يجمعون على أن الحركة لن تؤتي ثمرتها، لكن الإمام الحسين عليه السلام كانت له مقاييسه ونظرته التي لا يدركها هؤلاء. إننا حينما نتتبع الشخصيات التي دارت في مدار كربلاء ربما نستطيع القول أنه لم يدرك أحدًا مغزى حركة الإمام الحسين عليه السلام باستثناء العباس وزينب عليهما السلام وقلة من الأشخاص، والملاحظ أنه من الصعب على الحسين عليه السلام أن يشرح الأبعاد للعامة، وقد كان عامة الناس ينظرون إلى أن النصر هو الغلبة الظاهرية والإطاحة بالحكم، أما الحسين عليه السلام فقد كان يرى أن معنى النصر والغلبة أبعد وأعمق من ذلك بكثير، فقد كان يعلم بتبعات حركته ولم يخف أو ينف ذلك؛ لكنه رأى من خلال إدراكه الرباني الإلهي مالا يراه الناس، رأى أن سكوته ورضاه وقبوله بحركة يزيد وحكومته نهاية للإسلام والدين، فلو قبل وسكت لانتهى الإسلام ولفظ آخر أنفاسه في سنة 60 -61 هـ. نتوقف هنا لبحث الجانب الثقافي والفكري، نعيش اليوم أطروحات ومصطلحات ثقافية تشبه إلى حدٍ ما تم طرحه لتثبيط الحسين عليه السلام، وللتوضيح تطرح في زماننا مسألة الوسطية والاعتدال، فيقال عن فكر ما، أنه فكر معتدل وآخر فكر متطرف، وأن الإسلام دين الوسطية والاعتدال، وإن اتخاذ موقف ما يسمى تطرفا، ويطلق على أصحابه المتطرفين، ويبدو أن هذه الفكرة أُتقنت بحيث أننا نجد أكثر الناس مقتنعين بأن الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال لا دين التطرف. وهذا أسلوبٌ وطرحٌ ثقافي يختزن في باطنه الكثير من الغش والخداع والتزوير، وسوف نحاول الإشارة لهذه المسألة، إن كثيرا من الأخوة من أهل الإيمان والمعرفة لا يستطيعون التمييز بين الأطروحة الصادقة والأطروحة المخادعة الماكرة التي ربما ظاهرها ناعم ولكن في باطنها السم الزعاف. والوسطية بالمعنى المقصود: هو أن يتخذ الإنسان موقفا لا هو من أهل التشدد لهذا الطرف ولا من التشدد لذاك الآخر. إذا أردنا أن نحدد لنا موقفاً أو مسألة من المسائل ونتخذ فيها قرارا نبحث عن الناس أين يقفون وكيف يقيمون هذه المسألة وما يرون فيها، فلا نتبع الذاهبين جهة اليمين ولا الذاهبين في الجهة المقابلة، وإنما نقف في الوسط، وأصبح الميزان المطبق الآن هو أن تعرف أين يقف الناس أو الأكثرية منهم، فتأخذ موقفاً وطريقا وسطا مقبولاً، ونجد هذا المبدأ معمولًا به عند الناس في كثير من المسائل. فهل الإسلام هو دين الوسطية، وأن نرى موقف الناس ما هو ثم نتخذ طريق الوسط ؟ الجواب أن هذا هو موقف عبدالله بن عمر بن الخطاب، وقد شكل نموذجا واضحا جليا في هذا المعنى، كان شخصا يميل إلى التنسك والعبادة والبعد عن الخوض في نصرة أحد، ، فهو لم يبايع يزيدًا في أول الأمر، وإنما قال أنا مع الناس، أيضاً قبلها لم يبايع أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان يشكل طرفا في حرب الجمل وعائشة وطلحة والزبير في الطرف الآخر، هو لم يقف مع أي من الطرفين، ولم ينصر أحدًا منهم فهو يمثل معنى الوسطية التي مطلوب منا أن نتخذها في زمننا هذا. اليوم نجد الناس يقولون لا نذهب مع أهل الشمال ولا اليمين، وإنما نقف موقف الوسط وهذه الفكرة كثيرة الانتشار، مثلًا في جانب العقائد وحينما يدور الحوار بالانتماء لمذهب معين في الاعتقاد بالأئمة الطاهرين عليهم السلام المطلوب منا أن نتخذ موقفا وسطا لا نغالي في تأيد مذهب معين أو جماعة معينة، وإنما نتخذ الموقف الوسط، وهذا الأمر يتكرر في جانب العقائد والسلوك فيُطلب أن لا تقف لوحدك وإنما انظر للناس إذا ذهبوا إلى أمر فخذ أنت جانب الوسط. وحتى نوضح المسألة نرجع للقرآن والإمام الحسين عليه السلام وننظر، هل القرآن أمرنا بالتوسط بهذا المعنى، هل الحسين عليه السلام اتخذ موقفا وسطا، يقول الله تعالى: (( يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ))(1) ويقول: (( و إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ))(2) أول ما نلحظه في مقياس القرآن أنه لا تعطي قيمة لموقف الآخرين أو رأي الأكثرية منهم، أو أن ترى موقف الناس ثم تأخذ موقفا وسطًا، ويوجهنا القرآن أن موقف الناس ليس هو القائد والموجه والميزان للحق والباطل، يقول تعالى: (( فماذا بعد الحق إلا الضلال ))(3) القرآن يرشدنا أن الميزان هو ميزان العقل والمنطق والحجة والبرهان والنص الإلهي وأما ميزان مواقف الناس أو كثرتهم أو قلتهم في أي جهة فليس دليلا على الموقف السليم، بل الآيات تحدثت عن الأكثرية بصورة غير مادحة. إذن القرآن يحثنا لمعرفة الحق والباطل، لمعرفة اتخاذ القرار في المواقف، بأن لا نعتني بمسألة الوسطية، ولا نعط قيمة لرأي الأكثرية وأن ميزان الحق هو اتباع الحجة الثابتة سواء أيدها الآخرين أولم يؤيدوها. ربما يخطر في بالنا أن الإسلام هو دين الشدة، باعتبار أنه لا يرى عناية ولا اعتبارا للأخذ بالوسطية، لنلاحظ أن هناك مساحتين وجانبين نبحث فيهما، فعندما نبحث عن معرفة الحق والباطل وتكون الغاية التمييز بينهما لا يكون للأكثرية أو الوسطية ميزان أو قيمة، أما حينما يكون الأمر في مسألة هداية الناس وتوجيههم والأخذ بيدهم للحق يأتي ميزان الرفق والمحبة والرحمة والشفقة والحوار والاعتدال وإعطاء الآخر أحقية بيان وجهة نظره، الله تعالى يعلمنا أن دعوة الناس له يجب أن تكون بأسلوب وسط ومقبول للنفوس، وهذا فرق بينه وبين معنى الوسط والوسطية الذي يطرح الآن في الساحة، لاحظوا كيف تم الخلط بين المعنيين وشوهت صورة الحق باعتبار أنه دعوة للتطرف، وتم الأخذ بيد الناس للضعف والوهن في دينهم باعتبار أن هذا هو الاعتدال، إذن لتوضيح هذه الصورة نقول: أنه في جانب البحث عن الحقيقة وفي جانب حركة المؤمن للسير لله والتمسك بيد الفوز والفلاح وتمييز الحق عن الباطل فلا تعتني برأي أحد إلا إذا كان قائما على الحجة والدليل والبرهان القاطع، وليس باعتبار أنه رأي الأكثرية، وأما في جانب التعامل مع الآخرين بل حتى مع النفس ودعوتها لله والعبادة ليكن المنهج الرفق والتلطف، وهكذا يعلمنا القرآن‘ فال تعالى: " (( ولتكونوا أمة وسطا))(4). إن التميز بين المنهج الذي نتبعه في البحث عن الحق وإدراك الحقائق وبين المنهج الذي نتبعه في تربية أنفسنا وساحة الحوار مع الآخرين والدعوة لله ففي هذه الساحة نحن مأمورون بالرفق ورعاية الطبع الإنساني وأخذ النفس بما تتقبله ولا ننفرها؛ لأن هذا خلاف الحكمة والدعوة لله . وحينما نعود إلى الإمام الحسين عليه السلام نرى هذا الأمر جليا واضحا فلم يتأثر بالموقف السائد في العالم الإسلامي، فقد كانت السمة الغالبة على المجتمع هي الضعف والسكوت والخوف من سلطة وحكومة معاوية ويزيد، فلم ينظر عليه السلام إلى هذه الأكثرية التي خضعت وجعلت الميزان في اتباع الحق هو الغلبة والمكنة والقوة والكثرة، وفي نفس الوقت أخذ الأمة بأجمل وأفضل أسلوب قبلته نفوسهم وانجذبت حوله طباعهم، بحيث رأوا فيما أقدم عليه الحسين عليه السلام عين الإيمان والتضحية والدعوة لله، ورأوا فيما قام به الظالمون في مواجهة الحسين عليه السلام التجبر والظلم والطغيان، وبهذا حقق الإمام الحسين عليه السلام الهدف الذي تحرك من أجله والذي كان يخفى على كثير من أهل الرأي والبصيرة إن لم نقل جميعهم عدا من كان لهم علاقة خاصة بالإمام عليه السلام واستطاع استيعاب دعوة الإمام الحسين وحركته عليه السلام، وبهذا لا نجد أحدا يصف الحسين عليه السلام وما جرى عليه بمثل من يدرك غاية الحسين عليه السلام، فحينما وقفت زينب عليه السلام في مجلس يزيد بن معاوية لم تنظر إلى ظاهر الأحداث والفترة الزمانية والغلبة الظاهرية التي تحققت لبني أمية، فخاطبت يزيد: يا يزيد كد كيدك واسعَ سعيك فو الله لا تمحو ذكرنا ولا تميت دعوتنا ما جمعك إلا بدد) (5) إن رسالة محمد صلى الله عليه وآله أحياها الحسين عليه السلام، لتبقى حية ترفرف في قلوب المؤمنين، ولتكون نهجًا ينهجه المؤمنين حتى يتم الله هذه الرسالة على يد مولانا صاحب العصر والزمان (( عجل الله فرجه ))، السلام على الحسين وعلى علي بنت الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.. نسألكم خالص الدعاء... ________________________________________________________________ (1) (( يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم )) سورة المائدة آية 105 (2) (( و إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله )) سورة الأنعام آية 116 (3) (( فماذا بعد الحق إلا الضلال )) سورة يونس آية 32 (4) (( ولتكونوا أمة وسطا)) سورة البقرة آية 143- (5) خطبة السيدة زينب في الشام |
|
#4
|
|||
|
|||
|
الدرس الرابع
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، السلام عليك يا أبا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك لعن أمة قتلتكم ولعن الله أمة ظلمتكم. نشرع في الإشارة إلى فائدة، وركيزة ثقافية نستلهمها من حركة الإمام الحسين عليه السلام، أو نجعل أحداث كربلاء مثالًا واقعيًا لتثبيت هذا المبدأ الإسلامي، لا بأس بالتمهيد قبل الدخول في هذه الفائدة. معنى الثقافة والآثار المترتبة عنها: نتعرف بداية المعنى المقصود من الثقافة، والآثار المترتبة عنها، وعلاقة أنواع معارفنا الثقافية بعضها ببعض. الثقافة: هي المعارف التي يكتسبها الإنسان وتترك أثرًا في سلوكه وحالته المعنوية، وبهذا يتضح لنا أن مجموعة ما يكتسبه الإنسان بأي نحو من الأنحاء، فمنذ نشأته في عالم الدنيا يأخذ باكتساب أنواع مختلفة ومن مصادر مختلفة معنوية وحسية كمصادر السمع والبصر، وكلها تتراكم على النفس وتترك أثرًا معنويًا فيها، وبالتالي تترك أثرًا سلوكيًا، المعارف التي تنشأ مع الطفل ثم تتنامى بمجموعها تسمى ثقافة، وكل أثر علمي ومعرفي يكتسبه الإنسان ويترك في نفسه أثرا معنويًا، إحساسًا، رغبة، محبة، بغضًا، ألما، سعادةً ويترتب عنها سلوك، هذه هي الثقافة، وبهذا المعارف التي يتحصل عليها الإنسان وليس لها تأثير في جانبه المعنوي أو شخصيته أو إنسانيته أو حقيقته أو سلوكه تخرج عن كونها ثقافة، وإنما تسمى معلومات غير مثمرة وغير مفيدة، والأمثلة على هذا كثير، وللأسف الشديد هناك من يسوّق ويبيعنا هذه المعلومات الغير مفيدة على أنها جزء من الثقافة التي يحتاجها الإنسان. ولا بأس من الإشارة إلى نقطتين أساسيتين حول الثقافة، وحول حقيقة الإنسان المثقف أو غير المثقف: أولا :حقيقة الثقافة ليست مجموعًا كميًا، بمعنى هي ليست تراكم جمعي للمعلومات والمعارف، فإذا تأملنا نجد أن بعض المعارف لها أثر معنوي، وبعضها ليس له أثر، بعضها له تأثير في تكوين الإنسان وبعضها ليس له أثر في ذلك، وبعضها له مردودات سلوكية ومهارات اكتسابية، وبعضها ليس له ذلك، فكثرة عدد المعارف بحد ذاته لا تكون ثقافة، وإنما ما كان له أثر معنوي وتطبيق سلوكي هو الذي يستحق أن يوزن بميزان الثقافة ويقال عنه ثقافة، فكم من الآلآف المؤلفة من المعلومات التي يقضي الإنسان وقته وجهده في تحصيلها ولا تكّون ثقافة حقيقية، وكم من معلومةٍ أومعرفةٍ أو إدراكٍ توصل إليه الإنسان وهو قليل في مجموعه العددي، ولكن بعده المعنوي والروحي يكون كثيرًا وثمينًا؛ وذلك لما تركته هذه المعرفة من أثر معنوي وسلوكي، فالثقافة لا تقاس بالكم والعدد وإنما بميزانها وتأثيرها في شخصية الإنسان، أي في آثارها المعنوية عليه ومقدار ما تحمل له من سلوك، وبهذا المقياس فإن المعارف التي نكتسبها ثلاثة أنواع: النوع الأول: ثقافة نافعة باعتبار أثرها المعنوي الإيجابي على الإنسان، وأثرها السلوكي في تحسين وتطوير قدرات الإنسان وأخلاقه وعمله. النوع الثاني: المعرفة التي لها آثار سلبية، أي تأثيرها الروحي والمعنوي على الإنسان سلبي، وهذه ثقافة سلبية، تأخذ بيد الإنسان إلى السقوط والانهيار. النوع الثالث: المعارف التي لا تزيد في شخصية الإنسان ولا جانبه المعنوي، ولا تؤثر على سلوكه، وهي معارف هامشية، ومن باب المثال يذكر أن أحد كبار الصحابة له باع واسع ومعرفة بعلم الأنساب وقد تخصص بمعرفة كل قبيلة وأفخاذها وأسمائها وفروعها، وحينما يُسئل عن آية في القرآن الكريم يقول أنا لا أعرفها، مع أنه تسلم القيادة في العالم الإسلامي، ولكن نوع الثقافة التي يمتلكها هذا الصحابي لا قيمة لها، ومع الأسف الشديد نحن مبتلون بهذا النوع من المعارف التي لا يصح تسميتها بالثقافة، لأنه لا قيمة لها من الجانب الثقافي، وفي الواقع الخارجي يحفظ البعض أسماء شخصيات نجوم الفن والرياضة، وتراهم يجمعون من هذا النوع من المعرفة ما يشحن صدورهم وعقولهم ومشاعرهم ولكن أي قيمة وأي ثمن لذلك، بينما يقول أمير المؤمنينعليه السلام : (علمني رسول الله ألف باب، يفتح لي من كل باب ألف باب) دعنا من الألف باب الأولى عرفنا أنها كثيرة، لكن الألف باب الثانية التي لعلي عليه السلام كل منها هو يولد لعلي عليه السلام ألف باب، وربما ألف باب هي إشارة إلى ما يستوعبه العقل الطبيعي من الأعداد، وكل معلومة من المعلومات تفتح أبوابًا من المعارف الروحية والآثار وهذه هي التي تسمى حقيقة ثقافة، أما معرفة أسعار السلع وما يستجد في الأسواق وغيرها، هذه لا يمكن أن تسمى ثقافة، وليختر لها اسمًا كل حسب ما يناسبه ويقدره. ثانيًا: إن هذه الثقافات والمعارف المتعددة التي نمتلكها ليست في مرتبة واحدة، بل إن لبعضها سلطة وحاكمية على المعارف الأخرى، بعضها معارف حاكمة وبعضها تابعة، بعضها معارف متسلطة ولها قيمومة وبعضها عليها قيمومة. الفوارق في العلاقة بين المعارف الحاكمة والمعارف المحكومة: 1. الثقافة الحاكمة في داخلنا تتولى اتخاذ القرارات الأساسية في حياتنا، حينما يحدد الإنسان له اتجاه أساسيًا في الجانب العقائدي أو السلوكي فهو يعتمد على هذا النوع من الثقافة الحاكمة ذات الرتبة العالية. وحينما نريد معرفة الثقافة الحاكمة على إنسان ما، لننظر حينما يتخذ قرارات أساسية في حياته، وحينما يرسم المخطط الأساسي في حياته، الثقافة التي يعتمد عليها تكون هي الثقافة الأساسية والحاكمة في نفسه. 2. الثقافة الحاكمة دائمة وثابتة في نفس الإنسان، أما المحكومة فهي ثقافة مؤقتة زائلة تسكن في عقله وفكره ولها أثر معنوي ولكن يقبل الزوال، ويقبل التغلب عليه والتخلص منه. 3. وهو في غاية الأهمية، وهو أنه في نقاط التقاطع بين ثقافتين يملكهما الإنسان، ولكل منها أثر معنوي وسلوكي عليه، فإذا تداخلت مقتضيات هاتين الثقافتين، فالثقافة المقدمة هي التي تمحو وتزيل آثار الثانية، وهذا هو معنى الحاكمية، الثقافة الحاكمة في نفس الإنسان كلما واجهها معارض ثقافي حكمت حاكميتها على الثقافة الثانية. قال تعالى: "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ" سورة آل عمران: 135 الإنسان في داخله لا يخلو من أثر للثقافات الضارة، "أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ" المقصود أنه قد يقدم الإنسان على مواقف وأعمال غير نافعة في مقام سلوكه وسيره إلى الله، فيختلط سلوكه ولو بدرجات مختلفة ومتفاوتة بآثار معارف وثقافات غير سليمة في داخله، وحينما تبدأ معرفة غير سليمة وغير صحيحة في التفاعل تظهر آثارها المعنوية والسلوكية على النفس، فإذا كانت لدى الإنسان ثقافة صحيحة وحاكمة على نفسه فإنها تتغلب وتحكم "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ" الآية الكريمة جعلت ذكر الله هي الثقافة الحاكمة والمسيطرة على نفس الإنسان المؤمن في نقاط التقاطع بين الثقافات التي توجد داخل الإنسان. هاتان النقطتان الأولى وهي أن الثقافة إنما تقاس بآثارها وتأثيرها السلوكي والمعنوي في الإنسان والثانية أن الثقافة فيها حاكم ومحكوم، هاتان النقطتان أساسيتان إذا التفتنا إليهما تبدأ الصورة التي نفسر وندرك بها الأحداث والتي نعرف بها داخلنا تتجلى وتتضح لنا، لاحظوا كيف يبين لنا الإمام الحسين عليه السلام الحقائق في هذا المجال "النَّاسَ عَبِيدُ الدُّنْيَا، وَالدِّينُ لَعْقٌ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ يَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَايِشُهُمْ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ" بحار الأنوار الإمام الحسينعليه السلام يشير إلى أن هذه الأمة قبلت الرسالة، واعترفت بالإسلام والتوحيد والنبوة ولم ترفض شيئًا من مبادئ الدين، بمعنى أنها لم تقف أمام أصل الرسالة؛ ولهذا يقول يحوطون الدين أي يعتنون به ويتمسكون به وله عندهم قيمة ما درت معائشهم، مادام هذا الدين لم يصطدم ولم يتعارض مع ثقافاتهم الثانية. نتعرف على مصادر الثقافة الآخرى في الأمة الإسلامية وإذا تعارض هذان النحويين من الثقافة أيهما المقدم والحاكم، ويبين لنا الإمام الحسين عليه السلام القضاء الذي قضت به الأمة، وأي جانب اختارت. الأمة الإسلامية منذ بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سنة 60 -61 هجرية، التي وقعت فيها الأحداث كان عندها أرث ثقافي وثقافة مكتسبة. المصادر الثقافية لدى الأمة الإسلامية في زمان الإمام الحسينعليه السلام: الأول: ما ورثوه وما بني عليهم نظامهم المعيشي والقبلي في زمان الجاهلية قبل البعثة، ولا نريد الخوض في تفصيل القيم والمبادئ التي وجدت في الجاهلية، لكن يكفي دلالة أسمها على أسسها ،الجاهلية بمعنى أنها لم تنشأ نشأة سليمة صحيحة، وإنما كان مصدر هذه المبادئ هي المعارف القبلية التي توارثوها، والتربية القبلية التي يختزنونها، وإذا أردنا أن نشير بشيء من الاختصار لقلنا أن ثلاثة أمور هي غالبة وذات تأثير قوي في النشأة الجاهلية في هذا المصدر. الجانب الأول: القبلية ولاشك أن تكوين القبلية كان تكوينًا قويًا ومهيمنًا، لم يعمل الإسلام عمله التام في تحويل الولاء والعداوة والمحبة إلى أخوة إسلامية، وإنما بقي الولاء الثقافي للقبيلة، وكمثال على المسألة قبيلة الأزد التي كان على رأسها هانئ ابن عروة الذي كان مواليًا لأهل البيت ويحبهم ،فحينما كان هانئ على رأس تلك القبيلة كان يتخذ قراراته في الدفاع عن الإمام الحسين عليه السلام وتهيئة الأجواء لنصرته عليه السلام، وحينما جاء مسلم ابن عقيل في الكوفة وجد من هانئ كل الترحيب والتأييد، ولستجابت قبيلة الأزد لمسلم واندمجت مع دعوة الإمام الحسين عليه السلام، ولكن حينما قبض عبيدالله ابن زياد على هانئ وأسره، تولى أمور قبيلة الأزد عمر ابن الحجاج والذي كان أموي الهوى، ذا نفسية خبيثة وطماعة محبا للدنيا، فتخاذل الأزد في نصرة مسلم، بل إن موقفهم كان متخاذلًا في نصرة هانئ ابن عروة نفسه، حتى أن سائر المؤرخين يستغربون كيف أن قبيلة الأزد لم تدافع عن هانئ فضلا عن نصرة مسلم، عمرو ابن الحجاج أتخذ أسوء المواقف في حرب الإمام الحسين عليه السلام، ربما لو تتبعتم أحداث ما قبل يوم العاشر إلى يوم العاشر لوجدتم أن ذكر عمرو بن الحجاج يتكرر في كل موارد القسوة والتحريض على قتال الإمام الحسين عليه السلام ومنعه من الماء الذي كان هو حق لكل الموجودات، فقد كان عمرو بن الحجاج هو الذي أقام على طرف النهر لمنع الحسينعليه السلام من الماء، تأملوا موقف القبيلة، كانوا أنصارًا لمسلم ابن عقيل والحسينعليه السلام مع رئاسة هانئ للقبيلة، وأصبحوا حاملين للسيف في وجه الحسين عليه السلام مع رئاسة عمر بن الحجاج، هذا دلالة على قوة التربية القبلية التي كانت تعتمد على أن القبيلة وحدة واحدة تسير خلف زعيمها، وآثار هذه المسألة في غاية القوة، منذ يوم السقيفة والمسألة تدار بواسطة القوة والولاء القبلي. الجانب الثاني: المنهج الجاهلي والذي بقيت آثاره قوية في طاعة القوي واتباعه، فكان من يتولى الحكم ويستولي عليه تنصاع النفوس له، وتنحى جوانب معرفتها القرآنية والروحية والمعنوية جانبًا أمام اتباع القوي الغالب. الجانب الثالث: أن الوضع القبلي كان يعيش على نهج السلب والدخول في الحروب للاستيلاء على الغنائم، وهذا بحث طويل وربما لا نجد مشهدًا واحدًا في تاريخ الإسلام وقف أمام هذا الأسلوب القبلي كما وقف علي عليه السلام؛ لأنه بعد معركة الجمل لم يكن أحد يتصور أنه لن يكون هناك سلب، فهو أمر لا ينفك عن القتل والقتال في تلك العهود، الغالب يستولي على كل شيء، والمعركة الوحيدة التي لم ينهب فيها الغالب ولم يسلب ما لدى المغلوب كانت معركة الجمل، يقول بعض المؤرخين والمحللين غير المتدينين أن مشكلة علي عليه السلام هو أنه جعل مبدأه أمام المبدأ والمنهج الجاهلي المتوارث. المصدر الثاني: منشأه القرآن والإسلام، لكن هذا المصدر قد عمل عمله في تحريف أسس العقيدة الإسلامية والمبادئ التي أنطلق منها الإسلام، ولا نريد الخوض في هذا الجانب لأنه طويل ومتشعب، لكن فقط نشير إلى جانب واحد وهو أن الخليفة الأول والثاني منعا نقل أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتدوينها، وانتشر بين الناس أن الدين والتدين هو حفظ القرآن، ولهذا نجد طبقة كبيرة من الناس تفرغت لحفظ القرآن وتعليمه، بينما لا نجد من يتولى تعليم الناس وتعريفهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، القرآن يعطي أحكامًا عامة، أما معاني تلك الأحكام يحتاج لمن يفهم الرسالة ومعانيها، لمن استوعب أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وذلك ليشرح تلك المعاني القرآنية، كتمت تلك المعارف والمعاني وأبعدت، ولهذا لا عجب أن تكون أسوء فئة ذات انغلاق فكري ومشوه هم حفّاظ القرآن، فكان أسوء فكر وثقافة إسلامية وجدت في تلك الأزمنة من طبقة حفاظ القرآن الكريم، الذين كانوا يحفظون القرآن ويعلمونه ويتزمتون في ذلك، وينالون بذلك مظهر التدين ومنصب الشرف، ولكن كانوا ذو خواء وانحدار ثقافي وأصحاب ثقافة جامدة متعصبة، انتهى بهم الأمر ليكونوا الخوارج، أصل الخوارج وانطلاقتهم الحفاظ الذين كانوا يعلمون الناس تلاوة القرآن، لأنه لما مُنعت عنهم ثقافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحجبت عنهم تعاليمه، أنتهي بهم الأمر ليكونوا فئة الخوارج، هذه الظاهرة من أسوء الظواهر، ومتى بلغت الاضطرابات الثقافية أسوء مراحلها في الأمة وُجِد الخوارج؛ لأنهم ينشأون في مراحل التضارب الفكري. المصدر الثالث: الثقافة الدينية المطهرة الصحيحة التي وعت القرآن، وأدركت أبعاده، وفهمت معنى الرسالة الإسلامية؛ فلم تحفظ القرآن بدون وعي، وإنما فهمت ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما أراده من تلك الأمة. هذه المصادر الثقافية الثلاثة أصبحت في حالة من التصارع في نفوس الأمة، فأيها كان هو الجانب الغالب وأيها المغلوب، الجواب أن الثقافة الإسلامية أصبحت أسيرة، الغالبية العظمى لثقافة الأمة الإسلامية كانت أسيرة للمصدر الأول والثاني من مصادر الثقافة، ولم يتح للعارفين الواعين أن ينشروا معارف الإسلام على نحو يصبح هو القوي والمهيمن، بل إن آثار هيمنة الروح القبلية والروح الإسلامية المنحرفة كانت جلية واضحة، ولا نكاد نرى إدراك وغلبة روح الثقافة الإسلامية التامة إلا في أفراد معدودين، ولهذا نجد الإمام الحسين عليه السلام في يوم كربلاء أراد إعادة ترتيب الوضع الثقافي في نفوس هؤلاء، ويعلمهم ويعلم الأجيال بعدهم، أنه سوف تحتاجون إلى أنواع متعددة من المعارف والثقافة لكن ضعوا ترتيبًا لها، بحيث تكون ثقافتكم الدينية السليمة الصحيحة هي الثقافة المهيمنة، نحن اليوم بلا شك نعيش في بحور لأنواع من المعارف التي نحتاج إلى التعامل معها، لكن قبل ذلك نحتاج أن نضع تخزينًا وتصنيفًا مناسبًا لهذه المعارف في داخلنا، فنضع كل معرفة في محلها المناسب والصحيح، الإمام الحسين عليه السلام حينما خرج عليهم قال: (انسبوني من أنا ثم أرجعوا إلى أنفسكم فانظروا هل يحل لكم قتلي ألست أبن بنت نبيكم) أراد إعادة ترتيب المعنى الثقافي والروح الثقافية التي تهيمن على أنفسهم ( أليس أمير المؤمنين أبي، هل يوجد ابن بنت نبي غيري ) أعاد لهمعليه السلام مبادئ الإسلام الأساسية التي يعتمد عليها، الإسلام جاء لبناء نهج ثقافي يبتني على موالاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل الحق، ولكن حين نسيت وهجرت هذه المعاني وهذه الثقافة أمام ثقافة الجاهلية والفكر الإسلامي المنحرف، فتخلوا عن موالاة أهل البيت والحق، ونحن اليوم في زماننا نحتاج أن نجعل من ثقافة واقعة كربلاء المنطلق الأساسي لشخصيتنا، نحن نتعامل مع أنواع من المعارف والتعاملات المختلفة مع أجناس مختلفة من الناس، وإن شاء الله سنتعرض لمعاني الانفتاح، ولكن يفترض فينا أن نكون قد تربينا تحت ظلال معاني كربلاء، ولثقافة كربلاء مبادئ وهي: أولا: عدم الانغماس في الدنيا التي لا قيمة لها، ولو كان لها قيمة لم يكن يزيد هو الحاكم فيها، والإمام الحسين عليه السلام هو المطارد. ثانيا: رفض الظلم بجميع أنواعه وأبعاده. ثالثا: الاستعداد والتضحية. هذه الثقافة الكربلائية لا بد أن ننطلق منها في حياتنا، فتكون هي المهيمنة علينا، أينما ذهبنا وإلى أي جهة توجهنا، وفي أي مجال من مجالات الحياة التي نحتك بها، ونحتاج إليها ونتعامل بها، لتكون ثقافة كربلاء هي الثقافة الحاكمة على حياتنا، ولتكون هي الثقافة المهيمنة على الثقافات التي نعيشها في حياتنا. والحمد لله رب العالمين |
|
#5
|
|||
|
|||
|
الدرس الخامس
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك لعن أمة قتلتكم ولعن الله أمة ظلمتكم. في الدرس الماضي أشرنا أن الثقافة هي مجموعة المعارف التي لها دور في معنويات الإنسان، وبالتالي لها دور في سلوكه، ولو أردنا أن نرسم رسما بيانيا لجعلنا المعرفة أولاً، ثم يمتد منها الأثر المعنوي، ومنه يمتد السلوك والعمل، وقلنا إن الثقافة لا تقاس بالكم وإنما تقاس بما لها من تأثير، وأشرنا أن الثقافة حاكمة ورائدة وأخرى محكومة وتابعة. حديثنا اليوم في البحث عن كربلاء وثقافتها بنحو من التفصيل والعمق، من أهم الأسئلة أو المنطلقات التي نطرحها ما هو موقع ثقافة كربلاء، وما هو موقع قضية كربلاء في تركيبة الثقافة الإسلامية. واقعة كربلاء جرت في فترة معينة من التاريخ وأعطت معطيات ثقافية معينة، وفي تسلسل تركيبتنا الدينية هناك معارف أساسية ضرورية وهناك معارف ثانوية وإكمالية، فما تصنيف ثقافة كربلاء في الشخصية الإسلامية؟للإجابة نسأل كربلاء صناعة من؟ صناع كربلاء: من صنع كربلاء، ومن قام برسم ساحة الصراع في كربلاء وحدد الأهداف والغايات والصور والمعاني للأعداء والأولياء الجواب البديهي المتبادر الإمام الحسين الإمام الحسين، لكن لنتوقف قليلًا للبحث، فالمسألة لها أصل أبعد. الذي صنع كربلاء في الأساس والذي كان يراها بعينيه هو الرسول صلىالله عليه وآله، حينما حمل هذه الرسالة السماوية وتقبل التكليف الإلهي بأعمق تصور فكري وروحي عرفته البشرية، وبدأ بمجتمع جاهلي يعيش في دركات الجهل والظلم والتجبر والقبلية والجاهلية، حينما حمل تلك المعاني كان يصنع كربلاء، وكان يعلم علم اليقين بأن تحمل تلك المسؤولية له تبعات، حينما كان يقاتل العرب بمختلف أجناسهم ليقولوا لا إله إلا الله، وليحملهم هذه الرسالة الخاتمة، كانت خطوط كربلاء ترسم بيد المصطفى صلىالله عليه وآله، كان يعلم أنه لاستخراج الحق والعدل والإيمان والخشوع لله والطاعة له من بين هذه الأمة التي تشبعت بروح الضعف والبعد عن الله والقبلية والظلم كان لابد من حركة كربلاء، فكربلاء لم تكن صدفة تاريخية. الأمور لا تجري على نحو الصدفة، أن يكون فلان الخليفة الأول ثم الثاني ليس صدفة، نحن حيث لا ندرك أبعاد التركيبة للنفس الإنسانية نتصور أن الظروف التاريخية والصدف جّرت على هذه الواقعة، أما الرسول صلىالله عليه وآله الذي كان يبصر بنور الله فكان يعلم علم اليقين بأن هناك من سوف يدفع لهذه الحركة كل وجوده، وأن هذا الدافع والمُضحي لا يمكن أن يكون أحدًا غير ابن بنته وفلذة كبده. الصانع الثاني لكربلاء أمير المؤمنين عليه السلام ، حينما كان يخرج في وجه كل القبائل العربية شاهرا سيفه ليقتل فرسانها ورؤسائها كان يعلم بنتائج ذلك العمل، والصانع الثالث فاطمة الزهراء لما خرجت سلام الله عليها لمسجد الرسول صلىالله عليه وآله ووقفت في وجه الانحراف والظلم، والرابع الحسن عليه السلام عندما صبر على حكم معاوية وفضحه بالصلح معه، فقد كان كل منهم يضع لبنة من لبنات كربلاء، كربلاء ليست قضية جرّتها خصائص في شخصية يزيد وشخصية عيبد الله بن زياد وخصائص في إباء الحسين عليه السلام كما يخطر في بال بعض المثقفين. كانت كربلاء أمرًا حتميًا منذ اللحظة التي انطلقت فيها الدعوة، والدور الذي قام به صناع كربلاء كشف حقيقة أن الأمر سوف يصل لهذه اللحظات، ولهذا نجد أنهم صلوات الله عليهم كانوا ينظرون للحسين عليه السلام نظرة خاصة. الرسول صلىالله عليه وآله منذ اللحظة التي ولد فيها الحسين عليه السلام أشار لهذه الحقيقة، نحن نتصور أن مسألة ملك ينزل من السماء ويخبر الرسول صلىالله عليه وآله مسألة بعيدة عن النظرة الواقعة والإدراك المحمدي، الرسول صلىالله عليه وآله يحيط بأسرار الناس وحقائق الأمور وكان يرى في نظرة هؤلاء الكفرة والمنافقين العزيمة للخروج، وكان يرى إن إخرج الأمة من الظلمات إلى النور لا بد أن يمر في ساحة كربلاء، وكان يرى أن الحسين عليه السلام هو الحامل الحقيقي لتلك الشعلة، وكان يعلم علم اليقين بأن ما يقوم به يؤدي إلى نتيجة يعرفها، وتوضح زينب عليها السلام الأمر لما دخلت على الحسين عليه السلام وكان يردد تلك الأبيات وهو يصلح سيفه. يا دَهرُ أُفٍّ لَكَ مِن خَليلِ كَم لَكَ في الإِشراقِ وَالأَصيلِ فهمت حينها زينب عليها السلام ما كانت تدركه إدراكًا عامًا سابقًا، علمت حتمًا بأن هذا هو أوانه، فقالت يوم العاشر"اليوم مات جدي محمد المصطفى، اليوم مات أبي علي المرتضى، اليوم ماتت أمي فاطمة الزهراء، اليوم مات أخي الحسن المجتبى". (1)مِن صاحِبٍ وَماجِدٍ قَتيلِ وَالدَهرُ لا يَقنَعُ بِالبَديلِ وَالأَمرُ في ذاكَ إِلى الجَليلِ وَكُلُّ حَيٍّ سالِكُ السَبيلِ الحسين نقطة المحور: كان الحسين عليه السلام نقطة المركز والمحور الذي ظهر فيه جهاد رسول الله صلىالله عليه وآله ورسالته وشجاعة حيدر، وعزيمة الزهراء، وصبر الحسن لأنهم كانوا في كل خطوة يضعون أسس كربلاء. من هنا نفهم معنى فضل زيارة الحسين عليه السلام وزيارة كربلاء، عن أبي عبدالله قال:«كان الحسين بن علي عليهما السلام ذات يوم في حجر النبيّ وآلـï·؛ـه يلاعبه ويضاحكه، فقالت عائشة: يا رسول الله ما أشدّ إعجابك بهذا الصبي! فقال لها: ويلك وكيف لا أحبّه ولا أعجب به وهو ثمرة فؤادي، وقرّة عيني، أما إن أُمتي ستقتله، فمن زاره بعد وفاته كتب الله له حجّة من حججي، قالت: يا رسول الله حجة من حججك؟ قال: نعم وحجّتين من حججي، قالت: يا رسول الله حجتين من حججك! قال: نعم وأربعة، قال: فلم تزل تراده، ويزيد ويضعف حتى بلغ تسعين حجّة من حجج رسول الله صلىالله عليه وآله بأعمارها»(2). والظاهر أنها لو بقيت تقول يا رسول الله تسعين لبقي الرسول صلىالله عليه وآله إلى ما شاء الله، بدأنا نفهم أن وحقيقة الدين في كربلاء، ليس أن زيارة الحسين عليه السلام أفضل من الحج ولكن يمكن أن تكون مثل الصلاة بل أفضل منها وليس فقط أفضل من الحج والصلاة والصوم بل أفضل من كل عمل يتعبد به إنسان إلى الله؛ لأن الدين كله والثقافة الدينية كلها مجتمعة ومختزنة في كربلاء، صورة الدين بأبعاده كلها تحويها كربلاء، من هنا يأخذ البعد الكربلائي في الإسلام وضوحه. يتضح معنى أن يكون الإنسان واعيًا ومدركًا ومثقفًا بثقافة كربلائية، الثقافة الكربلائية ليست فقط أن نتعرف على تلك الحقائق والمآسي ونتأثر بجانبها الحزين المأساوي. إذا أردنا أن نعرف كربلاء من الجدير بنا أن نتتبع حركة الحسين عليه السلام وحركة أصحابه وماذا كانت آثار ثقافة كربلاء في نفوسهم، ثقافة كربلاء يمكن أن نشير إليها بنوع من التقسيم لهذه الإجمالية التي ذكرناها: جوانب ثقافة كربلاء وآثارها: ثقافة كربلاء أول جوانبها الإمامة، لا شك أننا ندرك معنى الإمامة ونفهم دورها، حاليًا العالم الإسلامي لا يعاني من بلاء بقدر ما يعاني من فقد معنى الإمامة، فما يحل بالمسلمين من مصائب إذا تدبر الإنسان فيها لوجد أن مدارها هو فقدان القيادة الواعية الرشيدة التي تأخذ بيد هذه الأمة، وليس فقط فقدان الإمام، نحن الإمامية في زماننا الحاضر لا نملك إمام محسوس بيننا، ولكن معنى الإمامة والارتباط بالمنهج الإمامي موجود، وبه نختار أقرب الطرق وأكثرها استقامة نحو الإمامة، وهو منهج العلماء والعارفين بالله ومنهج العادلين القائمين بالحق، وهذا هو الذي يحفظ عالمنا الشيعي من التمزق، أما مع الأسف الشديد سائر أبناء العالم الإسلامي يتخبطون في هذا المجال تخبط عشوائي، فمن الواضح أن هذا الجانب الثقافي هو أكبر ثغرة يعيشها الإنسان المسلم اليوم. الإمامة قد نأخذها ونستفيد منها على نحو أنها ركن من أركان الدين والعقيدة علينا التمسك به، وهذه مرحلة أولى وهي أساسية وضرورية ولكن على نحو آخر ودرجة أعلى الإمامة بمعنى الولاء، ولاء الروح والمحبة وليس فقط ولاء الاعتقاد والاتباع. في كربلاء نلاحظ أن الإمامة بمعنى ولاء الروح والمحبة هي الجو والمحيط الذي يطوق جيش الحسين عليه السلام ، والرابطة التي بين الحسين عليه السلام وأصحابه من أهل بيته وأنصاره رجال ونساء وأطفال تحولت كلها إلى ركيزة للمحبة والولاء الروحي. عجيبة أحداث كربلاء في ليلة العاشر من المحرم الحسين عليه السلام أذن لأصحابه في تركه، وكثير من القراء والخطباء يتحدثون عن معنى هذا الأذن، أنا بحسب رأيي هو أذن حقيقي شرعي بتركه عليه السلام ولم يكن أذن اختبار، وأنه اكتفى من أصحابه وأنصاره أن يبقوا معه إلى ليلة العاشر، وأقول حسب تقديري وفهمي أنهم لو تركوا الحسين عليه السلام لم يكونوا مؤاخذين. الحسين عليه السلام استنصر الناس وأمرهم بالخروج معه، أما ليلة العاشر فقد أطلق لكل من معه العنان وأذن لهم بتركه،ولكنهم في خلال مسايرتهم للحسين عليه السلام منذ خروجه من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى تلك الصحاري، حتى حل بكربلاء يوم الثاني من المحرم، وبعضهم التحق به في الفترة الأخيرة ولكن إلى حد ليلة العاشر من المحرم كانت الإمامة بمعنى الطاعة المفترضة من الله للإمام قد استقرت في نفوسهم، ولكنها لم تكن هي العامل الوحيد الذي يبقيهم مع الحسين عليه السلام فهناك شيء آخر. نقرأ أجوبتهم وما قالوا للحسين عليه السلام هل نفهم منه أنهم بقوا معه لأن هذا هو الواجب الرباني، يقول مسلم أبن عوسجة لما جمع الحسين عليه السلام أهل بيته وأصحابه وقال إن القوم يطلبونني وهذا الليل فاتخذوه جملًا فقام مسلم أبن عوسجه وقال: (أنحن نخلى عنك ولما نعذر إلى الله في أداء حقك أما والله حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي ولا أفارقك ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت معك)(3)أصبح القتل مع الإمام الحسين عليه السلام ليس فريضة وإنما هو غاية لهم، وقال سعيد بن عبد الله الحنفي:( والله لو علمت إني اقتل ثم أحيا ثم احرق حيا، ثم أذر يفعل ذلك بي سبعين مره ما فارقتك )(4)ويقول مسلم بن عوسجة الأسدي (والله لو علمت انى اقتل ثم أحيى ثم احرق ثم اذرى يفعل بي ذلك سبعين مرة ما تركتك)(5) لما جاء يوم كربلاء وخرج أصحاب الحسين عليه السلام واحدًا بعد آخر، خرج صبي لم يناهز الحلم كان أبوه قد قتل قبل قليل قال له الحسين عليه السلام ارجع إلى أمك لعلها لا تستطيع فراقك، علها تجد فيك خلفًا لأبيك، فقال يا أبا عبد لله أمي هي التي ألبستني لامة حربي، هذا الطفل حينما خرج قال: حسين أميري ونعم الأمير سرور فؤادي البشير النذير. هذا النحو من المعرفة بالإمامة هو نحو من المحبة الذي لا يرى في الإنسان وجوده إلا المحب الموالي لإمامه،كيف وقد رأوا الحسين عليه السلام ينثر عليهم المحبة، فقد خلق جوًا من المحبة كشفه لأصحابه وكشفه لكل الأمة الإسلامية، ربما من المناسب الإشارة بأن الحسين عليه السلام في معركته وخروجه وحركته لم يتخذ الأساليب العسكرية المناسبة، فلم يخرج خروجًا عسكريًا لقائد عسكري يريد الإطاحة بيزيد ودولته، إذا كان هدف الحسين عليه السلام هو الفتك بدولة يزيد والقضاء على دولته فقد تفتت بعد يزيد وانهارت، وبلغت الحضيض في وجودها وقيمتها بعد الحسين عليه السلام وفنت دولة معاوية وقامت دولة بني مروان. الإمام الحسين أراد أن يفتك بالظالمين من يزيد إلى قيام الساعة، لا أن يواجه يزيد فقط، أراد أن يبث في الأمة روحًا تحارب الظلم والظالمين إلى أن تُسلم الراية إلى المهدي عجل الله فرجه الشريف، هذا هو معنى ثورة وحركة كربلاء، وبالنسبة لإنسان يعي ويرتبط بالحسين عليه السلام في كل تكوينه وثقافته هو تابع لثقافة كربلاء. ذكرنا أن للثقافة حاكمية ومحكومية، في هذا الزمان نتعرض كثيرًا إلى مسألة وجوب أن نتعرف على ثقافات الأمم الآخرى وننفتح عليها ونكتسب منها، هذا كله صحيح بشرط أن تكون ثقافة كربلاء هي الحاكمة والمهيمنة فتطرد ما تشاء وتقبل ما تشاء، وذلك إذا حققنا في أنفسنا الثقافة الحسينية ، للإنسان أن تتسع معارفه ويبحث عن معارف جديدة ليكتسبها مستفيدًا من جهود الأمم الأخرى في سائر أنحاء المعرفة، لكن بشرط أن تكون ثقافة الحسين عليه السلام صلبة قوية راسخة في نفسه وتهيمن على معارفه ومكتسباته فتصبح هي الثقافة المحورية في تكوينه وسائر الثقافات والمكاسب العلمية والمعرفية تابعة ومنسجمة مع هذه الثقافة. نسأل الله بحق الحسين وجده المصطفى وأبيه علي المرتضى ان يصلي على محمد وال بيته وأن يجعلنا من المخلصين المحبين والحمد لله رب العالمين. (1) موسوعة شهادة المعصومين (ع) - لجنة الحديث في معهد باقر العلوم (ع) - ج 2 - الصفحة 183 (2)كامل الزيارات - الصفحة 144 (3) تاريخ الطبري - الطبري - ج 4 - الصفحة 318 (4) الإرشاد - الشيخ المفيد - ج 2 - الصفحة 92 (5) مناقب آل أبي طالب - ابن شهر آشوب - ج 3 - الصفحة 249 التعديل الأخير تم بواسطة بثينه عبد الحميد ; 07-08-2025 الساعة 11:47 PM |
|
#6
|
|||
|
|||
|
الدرس السادس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، السلام عليك يا أبا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك لعن أمة قتلتكم ولعن الله أمة ظلمتكم. في الدرس الماضي ذكرنا ركنًا من أركان مدرسة كربلاء الثقافية، وذكرنا إن الإمامة أمر أساسي وضروري لا يمكن أن يُستغنى عنه، ولا يمكن فهم الإسلام إلا به ومعه، وإن الإمامة بمعنى الانقياد ولزوم الاستجابة والطاعة لأولياء الله، ولها مرحلة عقلية عقائدية يعتقد الإنسان فيها ويسلم ويأتي بها امتثالاً لأمر الله، ولها مرحلة ثانية وهي مرحلة الولاء الروحي، وهي مرحلة أرقى رتبة من مجرد الامتثال والطاعة، ونشير إلى أن الإمامة لا تعني ولاء أئمة أهل البيت عليهم السلام في زمان حضورهم فقط، وإنما هي أمر ممتد في حضورهم وفي فترة غيبة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، وحينما يجعل الإنسان الإمامة غاية له وهدفا يتحرك من أجله فإنه يسعى إلى الارتباط بها وتحقيقها في عالم الخارج، حتى وإن بعُد الزمان بيننا وبينهم. بيننا وبين الرسول وآلـï·؛ـه ألف وأربعمائة عام، وبيننا وبين أمير المؤمنين عليه السلام قريب من ذلك، إلا أن الطريق والغاية والهدف مستمر، ولهذا يفترض أن نتقرب في عملنا وانقيادنا إلى أقرب صورة تعكس الإمامة، ولهذا فإن المرجعية الفقهية ليست إلا بحثا عمن يكون على نهج وطريق الأئمة عليهم السلام، فالمرجع ليس المقصود منه فقط الشخص الذي يعرف الأحكام الشرعية ويجيد دروس الفقه والأصول، وإنما المرجع هو الصورة التي نتوخى أن تكون واعية ومرشدة وقائدة إلى نهج الأئمة عليهم السلام. ننتقل إلى الركن الثاني في مدرسة الثقافة الحسينية وهو الاستقامة، ونجد المثال الحي للاستقامة هي حركة الإمام الحسين عليه السلام وقبل أن ندخل في طي البحث لنا وقفة تاريخية. أشرنا بصورة مختصرة في أوائل الدروس إلى أن حركة الحسين عليه السلام لم تكن هي الحركة الوحيدة التي انطلقت حيال بني أمية، فقد تعاصرت تقريبا في مدى قصير مع حركة عبد الله بن الزبير،وهي حركة كانت في مواجهة بني أمية، وعدم القبول بتحويل الخلافة معاوية أظهر شيئًا من التمسك بالدين، وإن كان أعلن مواجهته لخط الإمام علي عليه السلام وخرج عليه، فقد كان باغيًا وجائرًا على إمام زمانه، ثم أورث الحكم والخلافة ليزيد، وكان معظم المسلمين حينها منحرفين عن خط أهل البيت عليهم السلام، لكن لم تستقر أمورهم على الرضا بأن تكون قيادة أمور المسلمين إرثاً في يد بني أمية، فخرجت حركات تنكر، ومنهم عبد الله بن الزبير. بعض نقاط الخلاف بين حركة عبد الله بن الزبير وحركة الحسين عليه السلام: حركة الإمام الحسين عليه السلام ختمت بسرعة، ولم يأخذ مجراها فترة زمنية طويلة، وإنما امتدت عدة أشهر، من شهر شعبان حتى محرم الحرام خمسة أشهر تقريبا، ولم تتمكن من السيطرة والحكم وهذا أمر واضح. أما عبد الله بن الزبير فقد خرج مع الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة معترضًا على حكم يزيد رافضًا لخلافته وبقي في مكة مع بقاء الحسين عليه السلام ولكن الفترة التي كان الإمام الحسين عليه السلام في مكة، كانت الأنظار منصرفة عن عبد الله، بمعنى أن الناس مع وجود الإمام الحسين عليه السلام لم يكونوا لينظروا إلى ما يقوله غيره، بل كانت الأنظار منصبة على مواقف الحسين عليه السلام وتتتبع أخباره، وماذا سيفعله عليه السلام، وكان عبدالله بن الزبير كامناً،بعد خروج الحسين عليه السلام إلى العراق في شهر ذي الحجة وحدوث ما حدث في كربلاء تحرك عبدالله ودعا الناس لمبايعته بالخلافة، فبويع في مكة، وأيده أهل المدينة، واستمرت المعركة بينه وبين قوات بني أمية حتى هلك يزيد،ثم أمتد حكمه إلى البصرة والكوفة، وحتى الشام إلى سنة أربعة وسبعون، قرابة عشر سنوات وعبدالله بن الزبير يعتبر خليفة، وقد امتد حكمه ضعف حكم أمير المؤمنين عليه السلام، وكان لائذاً بييت الله الحرام، واجه جيش بني أمية مرتين وهو متحصن في بيت الله الحرام، ففي حكم يزيد أرسل له جيشًا بقيادة مسلم بن عقبة فرموا البيت الحرام وأحرقوه، ثم توفي يزيد فأنهار الجيش الذي أرسله، وعاد الجيش للشام، ثم عاد جيش الشام مرة أخرى في زمان عبدالملك بن مروان وحاصروا ابن الزبير وقتلوه في بيت الله. وكان عبدالله شخصاً قوياً ومدبراً وشجاعاً، فيه مواصفات كثيرة، لكن من الجهة التأثيرية الظاهرية حركة الحسين عليه السلام لم تبسط نفوذها، بينما عبدالله بن الزبير امتدت حركته من مكة إلى المدينة إلى سائر أنحاء الجزيرة وإلى العراق ولولا سوء تصرفاته وبعض النقائص في شخصيته لربما كان له دورٌ في التاريخ أكبر من هذا، لماذا النتيجة المختلفة بين الحركتين؟ لماذا لم يتمكن الإمام الحسين عليه السلام من القيام بدور على الأقل مثل طول وامتداد ثورة عبد الله بن الزبير، المقارنة بين الحركتين يعطينا العجب العجاب، ربما معظم الناس لم يسمعوا قصة عبدالله بن الزبير ولم يتتبعوا قضيته في التاريخ، فقد بقت في كتب التاريخ، بينما ذكر الإمام الحسين عليه السلام وفكره وكلماته جملةً، جملة تطن في أرجاء التاريخ منذ سنة 60-61 هـ إلى يومنا الحاضر، لا تكاد جملة ذكرها الإمام الحسين عليه السلام إلا ودوت في شرق الأرض وغربها، هناك سر في حركة الإمام الحسين عليه السلام. الطهر والاستقامة سر حركة الحسين عليه السلام: تميزت حركة الحسين عليه السلام بالطهر والاستقامة، عبد الله بن الزبير كانت حركته حركة عسكرية تسعى للحكم، وتسلك كل وسيلة تؤدي لتحقيق هذا الحكم، يظلم كما يظلم الآخرون، يتحالف مع كل الجهات، تحالف مع المختار والخوارج ولم يفِ لأحد منهم، اتبع كل وسيلة تدعمه كما سائر معظم الثورات، ربما يكون في حركته جانب من الدفاع، وربما في جانبه نبذة من نبذ الحق، لكن الاستقامة والطهر اللذان توفرا في حركة الإمام الحسين عليه السلام لم يتوفرا في حركة عبد الله، بل لم يتوفرا لحركة ثورية في التاريخ أبدًا، الإمام الحسين عليه السلام حينما تحرك لم يتبع الأسس والقواعد العسكرية التي يتحرك فيها الثوار، سار الإمام الحسين عليه السلام بأهل بيته وعياله، لم يباغت بني أمية وهذا خلاف الحركة العسكرية، الحسين عليه السلام أرسل مسلم بن عقيل وهو رجل المبادئ والقيم والأخلاق، لا رجل القوة والفتك، وهذا خلاف الحركة العسكرية، الحسين عليه السلام تحرك علناً وأمام الناس، وهذا خلاف القواعدالعسكرية، الإمام الحسين عليه السلام كان يبشر بموته من خروجه، وهذا خلاف القواعد العسكرية، خلاف الحركة التي تريد انقلابا وغلبة ظاهرية، لو أن الحسين عليه السلام كان يريد مثل حركة ابن الزبير لكان أسلوب حركته مختلفا تماماً. الطهارة والاستقامة في حركة الإمام الحسين عليه السلام حيرت العقول والقلوب، لم يكن من المعهود والمعروف مثل هذه الحركة والثورة، لا في أزمنة الجاهلية السابقة ولا في الزمان الذي عهده الناس وعرفوه، ولو أردنا شاهدًا على ذلك لما حُوصر مصعب بن الزبير الذي كان والياً لأخيه عبدالله على العراق-حوصر- من جيش بني أمية، ورأى آثار الهزيمة، وأنه سوف يقتل على كل حال، تردد بين الانسحاب -هو جاري العادة والمألوف- وبين المقاومة والبقاء،مع علمه بأنه سوف يموت، فنفسه حثته على الانسحاب، لكنه تذكر ما جرى على الإمام الحسين عليه السلام فقال بيت الشعر. إن الألى في الطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسي التأسي هو إقبال الإنسان على الموت من أجل أن يبقى أسوة، والشاهد أنه قال إن الذين في الطف هم المثال الوحيد الذي يعرفه مصعب ويعرفه العرب قاطبة، أن يقدم إنسان على أن يكون شهيداً بهذه الطريقة، حق أن يكون أسوة للناس، ولهذا نجد على مدى التاريخ من مختلف فئات المسلمين حتى ممن لا يوالي أهل البيت، بل حتى ممن لا يعرف الإسلام إذا مرت به ظروف ولحظات تحدثه نفسه بترك مبادئه والتراجع عنها، المثال الوحيد الذي ينير له الطريق هو الحسين عليه السلام، غاندي شخص بوذي يجله الهنود ويعظمونه يقول أنا تعلمت من الحسين كيف أكون مظلومًا لأنتصر. هذا يدل على أن كل ناظر إلى الحقائق لا يجد حركة طاهرة مستقيمة كحركة الحسين عليه السلام. الركن الثاني في الثقافة الحسينية: نستعين بآيات القرآن لنفصل في هذا الركن، قال تعالى: { فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا غڑ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}(1)وقال تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ} (2) القرآن هو المرجع الذي نحتاج إليه، بل هو المدرسة والمعلم الذي يقدم إجابات شافية حول وضعنا الثقافي الآن على أي نحو يكون، وكيف يكون تعاملنا الثقافي، نشير لبعض الاستفادات من هذه الآية. الآية تخاطب الرسول آلـï·؛ـه فأستقم كما أمرت ولم تخاطب أحدًا من الناس بالاستقامة، الآية لم تقل يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا استقيموا، الاستقامة مطلب خاص بالرسول آلـï·؛ـه، من هنا نعلم أنه مطلب من أشق وأدق المطالب، ليس هناك خطاب مباشر لغير الرسول آلـï·؛ـه بالاستقامة، طبعاً من هم في محل نفس الرسول آلـï·؛ـه هذا كلام آخر، لكن سائر الناس والمسلمين والمؤمنين ليسوا مخاطبين بالاستقامة ( فاستقم كما أمرت ومن تاب معك) الإسلام والقرآن يطلب منّا الاستقامة لكن كيف جعل استقامتنا، يقول أنت يا رسول الله استقم، وأيضا هؤلاء الذين يتوبون معك، والذين انجذبوا إليك يا رسول الله خذ بيدهم إلى الاستقامة، إذن نستفيد من هذه الآية بأن الاستقامة ليست أمراً يمكن أن يحققه الإنسان بنفسه، ليس هناك أحدٌ مكلف بالاستقامة إلا الرسول آلـï·؛ـه، أما نحن فمكلفون بأن نتوب مع الرسول آلـï·؛ـه، وهو يأخذ بأيدينا إلى الاستقامة، فهو المكلف باستقامتنا، ولهذا يقول علماء التفسير إن هذه السورة شيبت الرسول آلـï·؛ـه، آية(فاستقم كما أمرت ) وردت في سورة أخرى لكنها لم تشيب الرسول آلـï·؛ـه، ويعلل بعض المفسرين ذلك إنها شيبته لأن فيها ومن تاب معك أي أنت يا رسول الله مكلف بالاستقامة، ومكلف بأن تأخذ بأيدي الذين تابوا معك،أعنهم وأهدهم ووفّر لهم طريق الاستقامة، وهذه الآية تفيد كلا الركنين الذين ذكرناهما، الأول هو الإمامة لأن تحقيق الاستقامة ليس بيد الناس إلاّ أن يكونوا مع الرسول آلـï·؛ـه، فلابد من تحقيق الإمامة، والثاني أن نوالى ونتبع الرسول آلـï·؛ـه ومن هم في مقامه، فنتبع إتباعا يؤدي بنا أن نكون بمعية الحسين عليه السلام فتتحقق لنا الاستقامة. الركن الثالث العدل والنفرة من الظلم: الآية القرآنية الثانية تأتي مباشرةً بعد الأمر بالاستقامة {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ}، وهي مؤشر للركن الثالث وهو العدل ومواجهة الظلم والنفرة منه، الآية تؤسس لنا منهجاً فلم تقل لا تظلموا حتى نقول الآية نهت عن الظلم، بل ما هو أبعد واعمق من مجرد الظلم، أولا الظلم كما هو في استعمالات القرآن هو كل انحراف عن الشرع، فيشمل الكفر بالله والشرك والتجبر والطغيان بكل أنواعه، وكل كافر وكل خارج عن ربقة الدين هو ظالم (يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ غ– إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)(3)أعظم الظلم هو الشرك بالله، لكن أيضاً نستفيد منها ومن الآية ( يا بني ولا تشرك.....سورة لقمان) أنّ مادة الظلم الموجودة في الشرك هي عنصر من عناصر النهي عن الشرك، الشرك رأس كل انحراف لكنه أيضا ملازم للظلم، ومن أهم ما نفهمه من الآية {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} ليس فقط لا تظلموا ولا تشركوا بل لا تركنوا إلى الذين ظلموا، والركون كما يذكر أهل اللغة هو ميل إلى الشيء والاعتماد عليه، أن تجعل هذا الشيء ركناً لك تثق به وتعتمد عليه، وفي الحديث عن الإمام عليه السلام كما نقل ذلك في التفاسير قال الإمام علي عليه السلام: (قال ركون مودة ونصيحة وطاعة) تفسير الميزان الركون يشمل الركون الثقافي، بمعنى أنه إذا سلمت فكرك وعقلك للظلمة وما يأتي منهم وما ينبع من مدرستهم فأنك تكون قد ركنت لهم، الآية ( ولا تركنوا....ثم لا تنصرون) الإنسان المسلم لا يبني ثقافته وفكره على الانعزال عن سائر الأمم الأخرى وعدم الاستفادة منهم، التجارب الإنسانية فيها الكثير من الفوائد والعلوم التي يتوصل لها سائر البشر من الأمم المسلمة أو غيرها، والقرآن لا ينهانا عن هذا المقدار من الاستفادة، بل يؤكد لنا أن المعرفة الحقة مطلوبة {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً} (4) والحكمة هي غاية الإنسان المؤمن من أي جهة نشأت، حتى لو خرجت على يد ولسان غير المسلم، النهي أن نركن ونتكئ ونأخذ بأقوال وأفكار الظالمين ونثق فيها دون تحكيم ثقافة الإسلام وأحكام الشريعة، مع الأسف الشديد يمكننا القول بأنه من النادر أن تجلس في المجالس مع بعض الاخوة وإن كانوا من أهل المعرفة والعلم ولا تسمع طنين أقوال وأفكار الكفار على ألسنتهم، الكثير من أفكارنا الدارجة في ألسنتنا لو تبصرنا فيها لوجدنا منشأها ليس إسلاميًا، لا أقول المسائل العلمية والمعرفة الصحيحة، وإنما أقول الأفكار التي تؤثر على تصرفاتنا وسلوكنا وروحانيتنا كثير منها منشأه ومنطلقه خاطئومنحرف، وفيها ركون إلى الذين ظلموا. مثلًا القتل والدمار الذي يحل بالمسلمين في العالم، وما تقوله وتسوقه وسائل الإعلام لا نجد فيه إلا ما يميت القلب و يخدر ويجعلنا نغفل، ومع الأسف ينطلي هذا على كثير من الناس، فترى كثير منهم يرددون ما تسوقه وسائل الإعلام، وهذا مثال فقط، لا يظن أحدًا أن كل مسلك أو نوع من أنواع التعايش لأنه صادر من الغرب نتركه، أنا أقول لنا عقول تفكر وتعي، عندنا مرئيات وأساليب ونظر إسلامي نتحرك من أجله، أم أننا نستورد ما يتصرفه الغرب كما هو ونقدره ونحبه لأنه قادم لنا من الغرب، كثير من الأفعال والتصرفات التي لا ميزان لها، ولاعقل أوطبع إنساني يؤيدها، لكن لأنها وفدت إلينا مغلفة وعليها تجميلات غربية أصبحت مجرى العادة، لنراجع تصرفاتنا في الأمور الاجتماعية ومنها الأعراس والاحتفالات الكثير منها ربما منشأه ليس القيم والأحكام والثقافة الإسلامية، وأكرر الإسلام لا يعني الانغلاق، أو أن لا يغير الإنسان في أساليبه، لكن لا نصبح تبعاً ولا نملك تقييماً للأشياء، هذه التبعية التي دخلت في أسماعنا وعيوننا وعقولنا، أصبحنا نحتاج إلى أن يقيّم لنا الغرب ما يصح وما لا يصح، هذا موافق لشرائط حقوق الإنسان وهذا ديمقراطي وهذا غير ديمقراطي هذا انفتاح وهذا لا، ولا نملك حق التقييم، الحديث عن شيء يمسنا ونرى آثاره في العالم الإسلامي {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} {وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ} نحن في أمس الحاجة للاستفادة من هذا الركن الثقافي الذين تصوره لنا كربلاء. الإمام الحسين عليه السلاممنذ خروجه من مدينة جده آلـï·؛ـه إلى مكة واجتماعه بالمسلمين إلى خروجه إلى كربلاء كموسائل الإعاقة والتثبيط والمواجهة الداعية لتغير خطته ومنهجه كانت تغريه عليه السلام وكان يقول ( يأبى الله لنا ذلك ورسوله وحجور طابت وطهرت) الحسين عليه السلام لم يكن يقبل أن يعطي بيده إعطاء الذليل للظالمين، وبقى عنصر الاستقامة والنفرة عن الظلم أساس ثقافي يرثه أتباع الحسين عليه السلام جيلًا بعد جيل، ونرى إلى اليوم من شيعة أهل البيت عليهم السلام الجلاء والوضوح الفكري والابتعاد عن الظالمين وبغض الظلم الذي ورثوه من الإمام الحسين عليه السلام في اليوم الذي قام فيه في كربلاء. الخلاصة: تعرفنا على ثلاثة أركان في ثقافة كربلاء: الأول الإمامة وإن كان في الترتيب تأتي ثانيًا، والثاني الاستقامة،والثالث مواجهة الظالمين، ونكمل بقية الأركان الثقافية فيما بعد. والحمد الله رب العالمين (1)سورة هود:112 (2)سورة هود:113 (3)سورة لقمان:13 (4)سورة البقرة: 269 التعديل الأخير تم بواسطة بثينه عبد الحميد ; 07-09-2025 الساعة 12:05 AM |
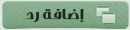 |
|
|